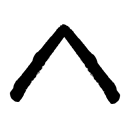تولوز، فرنسا | 7 كانون الأول/ديسمبر 2022
منذ انتقالي للعيش في مدينة تولوز الفرنسية، يحدث أن أنتبه فجأة إلى أنّني لست في لبنان! كأنني أخرج من رأسي - رأسي الذي لا يزال في لبنان - وأتأمل المدينة من حولي، لألاحظ أنّ هذا العالم الخارجي ليس مألوفًا لي، وإن كنت قد حفظته بعد أشهر على العيش والتنقل فيه.
أنتبه إلى أنّني لست في لبنان، وألقي اللوم فورًا على السفر جوًّا: أربع ساعات فقط من بيروت إلى باريس، وساعة إضافية من باريس إلى تولوز! هذا الاقتلاع السريع من مكان مألوف إلى مكان آخر غير مألوف بلا تمهيد وبلا عبور أو اجتياز هو بلا شكّ فكرة رديئة.
السفر بحرًا، ومعه الرحلات التي تدوم أسابيع طويلة، كان أكثر رأفةً بالمسافرين لأنه بطيء. يركب المسافرون على متن السفينة. يلوّحون بأيديهم للواقفين على المرفأ، ثم يبتعدون تدريجيًا عن الميناء، إلى أن يصبح البرّ نقطة. يقضون وقتًا في عرض البحر يكون بمنزلة فترة انتقالية بين البلدين، الأصل والمهجر، قبل رسو السفينة على برّ جديد. أمّا السفر على متن طائرة، فلا يمكنني تصوّره إلّا على الشكل الآتي: عملاق يحملني أنا - كائن واحد صغير - بين أصابع يده، ويقتلعني من مكاني في لبنان، ثم ينقّل كفّه العملاق لثوانٍ فوق خريطة العالم التي تعادل قصاصة ورق بالنسبة إليه، قبل أن يرخي قبضته المحكمة ويلقي بي في مكان آخر: فرنسا مثلاً.
أجد نفسي في مدينة جديدة بلا مقدّمات وبلا دليل للمستخدِم. "كمن يجد نفسه في الطريق، ويضطر إلى تدبير أموره بالموجود". هكذا تصف عُبيدة، في واحدة من قصص هذا العدد شعوراً ينتابها أحيانًا في غربتها. كنت أتساءل إن كنت المغتربة الوحيدة التي تخطر في ذهنها أفكار وتشابيه غريبة عن الهجرة. كان تساؤلي دافعًا لكتابة هذا العدد، انطلاقًا من الحاجة إلى خلق مساحة لتبادل التجارب عن الاغتراب، ولمواجهة السردية السائدة القائمة على تقديم الهجرة على أنها نزهة في البريّة.
كان عليّ أن أهاجر، أن أنتقل من زغرتا في شمال لبنان إلى تولوز، لأتذكر رجلًا عاد ليسكن في بيته في حيّنا عندما كنت صغيرة. كغيره كثر من المغتربين، عاد بعد غربة دامت سنوات طويلة في أميركا اللاتينية. في ذاكرتي صورة عنه لا أستطيع التأكد من دقّتها. أتذكره متعبًا طوال الوقت. وجهه داكن. لست متأكّدة إن كان كذلك فعلًا، أو إذا كنت أعطيه صفات تجعلنا، أنتم وأنا، ننظر إليه بعين مختلفة عن تلك التي قوبل بها في الحيّ. عند عودته، تناقل الجيران فيما بينهم أخبارًا عنه لا أذكر منها شيئًا. أذكر فقط، وبوضوح شديد، قولهم عنه إنّه "غَشيم". قالوا عنه حرفيًا: "آيش طِلِع غَشيم". كلّ هذا لأنَّ فرصة الاغتراب سنحت له فعلًا، لكنه عاد إلى لبنان بلا ثروة وبلا جنسية أجنبية.
يحضر هذا الرجل في ذهني منذ أن بدأت العمل على هذا العدد. أفكّر فيه على أنّه البطل المُضاد للأسطورة التي نسجها اللبنانيون عن الاغتراب: تماثيل لمغتربين تبرعوا بتشييد كنيسة أو ترميم طريق في مسقط رأسهم، ترافقها لوحة تُحفَر عليها أسماؤهم، تسبقها صفة "مغترب" كما لو كانت رتبة ما. صفحات في الجرائد مخصصة للاغتراب تُنشر فيها قصص النجاح حصرًا لأطبّاء ومهندسين وكتّاب لمعوا في الخارج. فيلّات ضخمة لمغتربين في ضيعهم تروي للمارّة قصص نجاح أصحابها بلا حاجة إلى الكلام.
تقول الأسطورة نفسها إنّ للنجاح (ما هو النجاح أصلاً؟!) في الاغتراب وصفة جاهزة، لأنه غير مشروط بتجاوز عقبات يفرضها النظام اللبناني على المقيمين فيه، كالفساد والوساطات وانعدام الفرص وقلة الموارد وعدم الاستقرار... من هذا المنطلق، تفترض الأسطورة أنّ أيّ مغترب لبناني هو بطل محتمل لقصة نجاح إضافية. وفي حال لم يحقق النجاح، وفقًا لتعريف الأسطورة له، فهو بالتالي المسؤول الوحيد عن ذلك، باعتبار الحياة في بلاد الاغتراب كلّها من دون استثناء خالية من الصعاب. في قصة أخرى من قصص هذا العدد، يروي زياد، مغترب لبناني في باريس، أن مغتربًا آخر قال له بعدما انتبه إلى أنّ الحياة في باريس ليست بألف خير: "كذّبوا علينا المغتربين!".
في الحقيقة، المساحات التي تتيح للمغتربين مشاركة قصصهم وإدراكهم تجربة الاغتراب ليست كثيرة. حتى في المساحات الخاصة، يتردّد عدد كبير منهم في مشاركة القريبين إليهم في لبنان مشاعرهم والصعوبات التي تواجههم في المهجر. يلجأ بعضهم بصورة واعية أو تلقائية إلى ترتيب المعاناة وفقًا لمقياس غامض، كما لو كانت بحوزتهم آلة لقياس المشاعر وتحديد أهميّتها. يقررون، على هذا الأساس، أنّ المشاعر الناتجة من التخبّط الهويّاتي الذي يعيشونه مثلًا كمغتربين أو من أي مشكلة تواجههم في حياتهم اليومية هي مشاعر غير مُستأهِلة وغير مشروعة أمام معاناة المقيمين في لبنان، ولا سيما منذ تعاظم الأزمة التي يشهدها البلد منذ نهاية عام 2019. في قصة أخرى، تتذكّر سُهى، مغتربة لبنانية في تولوز، قَول جارتها البيروتية لها: "منيح إنك تركتِ كل شي ورا ضهرِك وفَلّيتي". مَن قال إنها تركت "كلّ شي ورا ضهرها"؟
على أثر الأزمة الاقتصادية والمالية المتفاقمة، وصل عدد اللبنانيين الذين هاجروا من لبنان خلال الأعوام 2018- 2021 إلى ما يقارب مئتَي ألف لبناني، بحسب دراسة أجرتها شركة "الدولية للمعلومات". في سياق الهجرة القسرية التي يشهدها لبنان، تُخصّص مَجاز العدد صفر لطرح مسألة الاغتراب بعيدًا من الاحتفاء، ولإتاحة الفرصة أمام المغتربين ليتحدثوا عن الاغتراب كما يختبرونه بأنفسهم، باعتبارهم المعنيين المباشرين بالمسألة.
التقيتُ ثلاثة مغتربين لبنانيين في فرنسا: زياد وعُبيدة وسُهى، كل على حدة، وتحدثنا لساعات عن إدراك كلّ منهم لتجربة الاغتراب. وفي ختام كلّ جلسة، طرحت عليهم سؤالًا أطرحه على نفسي منذ انتقالي إلى فرنسا: "وين بدك تموت/ي؟"، باعتبار هذا السؤال يفتح في الذهن والقلب نوافذ أكثر إضاءة من سؤال: "وين بدك تعيش/ي؟".
هذا العدد هو دعوة لتحرير النقاش حول الهجرة، وللتفكير فيها من منظار هؤلاء المهاجرين وغيرهم، ولإعادة النظر بعملية نقل التجربة، ما تختزله وما تُبقي عليه، بهدف تفكيك أسطورة المغترب اللبناني ومواجهتها بسردية حقيقية وإنسانية لتجربة الاغتراب.
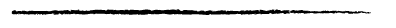
التقيتُ زياد شلهوب يوم السبت 14 أيّار/مايو 2022 في باريس. تواعدنا في الباحة الخلفية لمقهى "شي منى". تحدّثنا ساعتين أو أكثر، ثم مشينا ساعتين إضافيتين في شوارع باريس، تابعنا خلالهما حديثنا من دون تسجيل للصوت أو تدوين في الدفتر. بعدها، التقطتُ له ثلاث صور فورية.

راسكيفا (قرية في شمال لبنان) حلوة، لكنّ باريس أحلى. هكذا أقنع زياد نفسه بأنّه سيكون سعيدًا في فرنسا، وأنّه قادرٌ على التأقلم، وأنّ هجرته لن تكون أصعب من بقائه في لبنان. وصل إلى فرنسا. وبعد فترة قصيرة، اصطحبه صديق لبناني لمشاهدة برج إيفيل للمرّة الأولى.
عندما وصلا، كان صديقه المهندس المعماري متشوّقًا لرؤية ملامح الإعجاب والانبهار على وجهه. في تلك اللحظة، تلقّى زياد رسالة نصيّة من أصدقائه في لبنان، تضمّنت فيديو لأول تساقط للثلوج في ذلك الموسم. قبل أن تتسنّى له مشاهدة الفيديو كله، التفت إلى صديقه وقال بحسرةِ من فوّت لتوّه فرصة العمر: "عم تتلج بإهدن ولَيْك نحن وين!".
في الطريق من بيته في راسكيفا إلى مطار بيروت، انتهى كلّ شيء. شعور بالانسلاخ. يقول صديقه الذي أقلّه إلى المطار يومها – هو نفسه الذي اصطحبه لمشاهدة برج إيفيل – إنّهما لم يتبادلا الكلام طوال المسافة من راسكيفا إلى شكّا. سكوت تامّ في السيارة. كلمة واحدة كانت كفيلة بانهياره.
هجرته لم تبدأ بمغادرته الأراضي اللبنانية، بل بمغادرة راسكيفا. ترك بيته، وترك أمّه وحدها فيه. "وطلعنا بالبحر"، يقول زياد مشيرًا إلى بداية المشوار، كما لو كانت هجرته رميًا في عرض البحر، لا سفرًا هادئًا على متن طائرة تنقله من بيروت إلى باريس بأربع ساعات فقط.
غادر زياد راسكيفا في أواخر شهر آب/أغسطس 2020، إثر تعاظم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية. في تلك الفترة، صار يشعر بالضيق، وأدرك أنّ تحقيق المشاريع المهنيّة التي كان يخطط لها لم يعد ممكنًا. عندما انتبه إلى ذلك، قرر ألا يكمل حياته في بلاد لم تعد الأحلام فيها ممكنة. فكّر في الهجرة، وقارن بين عددٍ من البلدان، قبل أن يتبيّن له أن نمط الحياة في فرنسا هو الأقرب إليه.
بحث في سبل الهجرة إليها، فوجد أنّ الدراسة هي أسهل مدخل لتحقيق غايته. تسجّل في برنامج ماجستير في إحدى الجامعات الفرنسية، ليتخرّج بعد سنة واحدة وينخرط في سوق العمل. على الرغم من كلّ هذا التفكير والتخطيط، يصرّ زياد على أنّه لم يغادر لبنان عن سابق تصوّر وتصميم.
كان راضيًا عن حياته في لبنان. وأكثر بعد، كان سعيدًا. في فرنسا، اكتسب خبرات عدّة، كتجربة العمل في شركة كبرى، أو تجربة العيش وحيدًا والاستقلالية والنضوج الذي لا يُحتسب بالسنوات، أو تجربة العلاج النفسي مع كل ما يرافقها من فهمٍ للذات، والتي لم يكن ليخوضها لو لم يترك لبنان.
في ميزان الربح والخسارة، لم يكن أيّ من هذا ربحًا مجانيًا. بانتقاله إلى فرنسا، خسر زياد سنتين من عمره، كأنّه هجر نفسه لا بلده: "خسرت سعادتي اللي كانت بلبنان. لهلق ما عم لاقيها، بفتّش بفتّش عليها ما بلاقيها".
أكثر ما يشتاق إليه منذ مغادرته لبنان هو زياد القديم. يشتاق أيضًا إلى الجبال، إلى بلدته، وإلى المكان. لو زاره في عطلة الصيف كلّ من يحبّ من عائلة وأصدقاء في فرنسا، لأراد في كل الأحوال أن يزور لبنان بنفسه. الأمور بالنسبة إليه لا تقتصر على الناس، فهو يشتاق إلى الأماكن أيضًا، وإلى بيئة متكاملة كانت تحيط به.
يشتاق إلى بيته، وإلى غرفة الجلوس. إلى الجيران ومواعيد زياراتهم العفويّة، إنما المنتظمة انتظامًا طبيعيًا. إلى القيلولة بعد الظهر على الكنبة، لا في السرير. يفتّش عن لبنان في باريس، عن "قعدة" يرتاح فيها، كجلوسه على المرجوحة على شرفة بيته في لبنان. يضحك: "كنت إقعد عَ المرجوحة يدقّولي يقولولي وينك، قلّهم قاعد عَ العرش، كنت مسمّى المرجوحة العرش". يفتّش عن مقهى واحد يرتاح فيه بين آلاف المقاهي في باريس. لا يجده، مع أنّه كان يستكين في زغرتا أو طرابلس لأيّ مقهى عاديّ لا طعم له، ولا لون، ولا رائحة.
يقول زياد إنّه لم يترك لبنان ولدًا. لو تغرّب في الخامسة أو السادسة عشرة لكانت تجربته أسهل. أمّا اليوم، فعليه أن يتغيّر ويتأقلم في بلد آخر بعد أن بنى شخصيّته كلها وشكّل هُويّته في لبنان. "متل الختيار"، يعلّق. في إحدى المرّات، قرأ توصية باصطحاب الأشخاص المصابين بمرض الألزهايمر إلى الأماكن التي عاشوا فيها أولى مراحل حياتهم، حيث تشكّل وعيهم الأول. وجد في هذا الخبر الطبي مبررًا علميًا لتعلّقه بأماكن طفولته.
في كلّ مرّة يذكّره هاتفه بصوره في لبنان، يسأل نفسه: "وين راحت هالحياة؟". تقول له أخته التي سبقته إلى العيش في فرنسا إنّ الإنسان يعيش حيوات عدة في حياة واحدة. يجيبها أنه لم يكن يريد عيش حيوات عديدة. يريد لنفسه حياة واحدة دون غيرها من الحيوات.

منذ انتقاله للعيش في فرنسا، واظب زياد على رياضة الركض التي كان يمارسها في لبنان بانتظام. كان يركض على طرق ضيعته. أمّا في فرنسا، فهو يركض على طرف الطريق؛ أيِّ طريق. "بتعرفي ليه بركض هون؟". يسأل ويجيب: "بركض حتى يضل عندي القوّة ويضلّ جسمي متعوّد كرمال نهار اللي برجع فيه ع لبنان إقدر كمّل ركض، كمّل حياتي من محل ما وقفتها". يفكّر زياد في هجرته على أنّها توقّف موقّت لحياته، لا بوصفها استمرارًا طبيعيًا لها.
في أولى فترات هجرته، لو أخذ أحدهم بيده وقال له: "تعا نرجع إلى لبنان"، لكان قد عاد ربما، لكنّه غير قادر على اتخاذ القرار بمفرده. عشيّة الانتخابات الفرنسية التي شهدت خسارة مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان، التي كانت تعتزم التضييق على المهاجرين، أمام الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون، كان شيء ما داخل زياد يتمنّى لو تربح لوبان وتجبره على العودة إلى بلاده. يقول ممازحًا: "كنّا رجعنا ع بلادنا من دون ما نحسّ بالذنب إنو يمكن عملنا قرار غلط، كان السبب لعودتنا خارج عن إرادتنا"، لكنّ ماكرون ربح الانتخابات الرئاسية، وأُجبِر زياد على البقاء في فرنسا.
بعد مرور فترة على عمله في شركة بناء، استطاع أن يؤمّن لأحد معارفه في لبنان وظيفةً في الشركة نفسها. عندما حان موعد مغادرة زميله لبنان، حيث لا تزال زوجته تعيش مع أولاده، شعر زياد بالذنب لأنه يعرف ما الذي ينتظره في الغربة، ولا سيما أنّه توهّم -مثلما حصل مع زياد قبل الهجرة- أنه سيعيش مرتاحًا بلا همّ ولا غمّ، وأنّ الحياة في فرنسا هيّنة وبلا صعوبات، لأن كل شيء مؤمّن، والدنيا بألف خير. انتقل الرجل إلى فرنسا، وسرعان ما اكتشف أنّ الحياة ليست بخير. في أحد الأيام، قال لزياد: "كذّبوا علينا المغتربين".
وين بدك تموت؟
"بْخاف خَتْيِر بفرنسا". لا يهمّه أين يموت. يهمّه ما يسبق الموت. يخاف زياد من قضاء آخر أيام حياته في دار للعجزة في فرنسا أو وحيدًا في شقة. يفضّل أن يكون في بيته في لبنان؛ أن يكون عجوزًا في ضيعته، حيث يعرف كل الناس ويعرفونه.
من جهة أخرى، تخيفه العودة إلى لبنان بعد أن يكون قد أمضى عمره في فرنسا، وألا يعرف أحدًا في بلده، أو أن يجد نفسه عجوزًا من دون كهرباء ولا مياه ولا تأمين ولا شيء. يخاف أن يجد نفسه، بعد خمس سنوات مثلًا، غير قادر على العيش في لبنان أيضًا. يقول: "بصير معلّق، لا هون ولا هونيك".
لا يفكّر زياد في الموت كثيرًا، لكنّه يفكّر فيما يسمّيه القوّة القاهرة أو سلطة الأمر الواقع. يشرح أنه لو أصيب بمرض مُميت، وقيل له إنه سيموت بعد شهرين، سيكون سعيدًا عندها على الأقل، لأنه سيرجع إلى لبنان، وسيعيش آخر أيام حياته سعيدًا ومرتاحًا. "بدي شي يجبرني إرجع"، يقول. باريس حلوة، لكنّ راسكيفا أحلى.
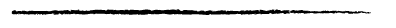
التقيتُ عُبيدة الحنّا يوم الأحد 15 أيّار/مايو 2022 في باريس؛ اليوم الذي أقيمت فيه الانتخابات النيابية في لبنان. تحدّثنا لساعة وربع ساعة عن الغربة. بعدها، التقطت لها صورة فورية أمام نافذة شقّتها. نصف وجهها في الضوء، ونصفه الآخر في العتمة. سألتها عن مكان في المدينة تشعر بأنه يعبّر عنها لألتقط لها صورة فيه، فأجابت: محطّة القطار. الرحيل إذًا.

عُبَيدة! كانت تمشي وحدها في الطريق عندما سمعت اسمها للمرّة الأولى يصدح في مرسيليا. التفتت نحو مصدر الصوت لتجد صديقًا لها. التقيا صدفةً من دون تخطيط مسبق ومن دون مواعيد. تشتاق إلى العفويّة. تجد في المشي في شوارع مدينة لا تعرف فيها أحدًا شيئًا من الحرية، لكنها تفضّل شعور الألفة عليه. تشتاق إلى التحدث باللغة العربية كل الوقت. تشتاق إلى الناس، إلى الشمس والمكان، على الرغم من أنّ المشهد في لبنان "مُخرَّب ومُبشَّع"، فيما المشهد في فرنسا أكثر رفقًا بالعين. لا تزال عالقة بين البلدين.
كل يوم. تفكّر عُبَيدة في العودة إلى لبنان كلّ يوم. تقول إنها سعيدة في فرنسا. هي سعيدة فعلاً، لكنها تسارع، كل مرّة تتحدث فيها عن الموضوع، إلى تكرار الجملة نفسها، كأنها في الحقيقة ليست سعيدة! ليست متأكدة. تمرّ تجربة الهجرة بالنسبة إليها كتواتر الفصول. تمرّ مراحل تَنسى فيها أنها مغتربة، ومراحل أخرى تحاول فيها أن تعيش التجربة كأيّ مغترب من أيّ دولة في العالم؛ كمغامرة في مكان جديد، بلا تعقيد.
ربما تعود إلى لبنان يومًا ما. وما لم يأتِ هذا اليوم، ستبقى في فرنسا. تنتبه إلى أنها بلا مكان تعود إليه أصلًا. كأن يدرك الإنسان فجأةً أنه ما عاد عنده بيت. كأن يجد نفسه في الطريق ويضطر إلى تدبير أموره بالموجود. ربما تبالغ بالتشبيه.
تقول لنفسها في محاولةٍ للحسم والمضي قدمًا: "خلص، هيدي حياتي ورح تكون كل الوقت هون [في فرنسا]". مع ذلك، تفكّر في العودة إلى لبنان. تأخذ هذه الفكرة أشكالًا مختلفة كلّ مرّة. تأخذ شكل سؤال عن جدوى الحياة في الغربة، أو حديث عن الأصحاب والعفوية في العلاقات، أو طبيعة الحياة اليومية مع أهلها وعائلتها وأصدقائها في لبنان. بالفعل، تأخذ هذه الفكرة أشكالًا مختلفة كلّ مرّة، لكن الثابت الوحيد فيها هو الآتي: "ما فيني كون حاسمة إنو حياتي رح تكون كل الوقت هون [في فرنسا]".
الناس يرحلون دومًا. يكتشفون مدنًا جديدة. يقعون في حبّها ويقرّرون البقاء فيها. هذه أمور تحصل كلّ يوم. ليست الهجرة ما يحزنها. يحزنها أنَّه ما من خيار سواها.
غادرت عُبيدة لبنان إلى مرسيليا في أيلول/سبتمبر 2018 للدراسة، ثم غادرتها إلى باريس للعمل في مؤسسة فرنسيّة تدرّب كبار الإداريين في مجال الضمان الاجتماعي.

أثناء متابعتها مجريات الانتخابات الرئاسية الفرنسية في نيسان/أبريل 2022، استمعت إلى مرشّح اليمين المتطرّف إريك زمور، في إحدى المقابلات التلفزيونية، يحذّر ممّا سمّاه "لَبْنَنَة فرنسا"، في إشارةٍ إلى "البؤس والنزاعات الطائفية" التي يشهدها لبنان. للوهلة الأولى، أرادت أن تجمع أغراضها وتعود حالًا إلى لبنان. شعرت بالإهانة. استفزّها كلامه، لأن المقارنة بين الواقعين اللبناني والفرنسي غير دقيقة بالأساس، ولأن الخطاب التقسيمي الذي يروّج له زمور في فرنسا، وأمثاله في لبنان، هو جزء من المشكلة وممّا آلت إليه الأمور في البلد.
تمنّت ألّا يكون زملاؤها في العمل قد شاهدوا المقابلة. خجلت من هذا التمنّي، لكنها فكّرت في صورتها أمامهم في اليوم التالي عندما تدخل المكتب. كانت مقتنعة في السابق بأنّها نجحت في وضع مسافة بينها وبين لبنان، وأنها مسؤولة عمّا تفعله أو تقوله هي فقط، وليس عمّا يحصل بشكل عام فيه. بعد استماعها إلى هذه المقابلة، تبيّن لها العكس. كأنها متماهية مع البلد. كأن ما يُقال عنه يُقال عنها هي. كأنها هي لبنان.
قبل انتقالها إلى فرنسا بسنتين، انتسبت عُبيدة إلى حركة "مواطنون ومواطنات في دولة" عند تأسيسها عام 2016. بعد مضي أربع سنوات على هجرتها، لا تزال عضوًا فاعلًا وملتزمًا في الحركة. لا تعرف كيف تصف التزامها السياسيّ في بلد من المرجّح ألّا تعود يومًا للعيش فيه.
بالمنطق السياسي، إذا كانت السياسة هي إدارة شؤون المدينة وسكّانها، فيُفترض بها أن تكون ملتزمة سياسيًا في بلد إقامتها، حيث تدفع الضرائب، وحيث تؤثر السياسات العامة مباشرة في حياتها اليومية، لكن جسمها في مكان وعقلها في مكان آخر. تبحث عن السبب ولا تجد إلا الفرضيّات: ربما يعني التزامها السياسي أنها في لاوعيها ترغب في العودة إلى لبنان، أو أنه شعور بالواجب أو بالمسؤولية تجاه مكان تعرفه وتجاه الناس فيه، أو أنه أمل بتغيّر مسار الأمور بشكل يصبح فيه البلد، بعد عشر أو عشرين سنة، مكانًا قابلًا للعيش. لم تطوِ بعد صفحة لبنان.
ربما يكون اليوم الذي تنسحب فيه من حركة "مواطنون ومواطنات في دولة" هو اليوم الذي تقطع فيه الحبل الذي يربطها بالبلد. لا تملك جوابًا. في الوقت الحالي، تعتزم تخصيص المزيد من الوقت لنشاطها الحزبي. التزامها السياسي هو ما يعطي حياتها معنى. تقول: "للمفارقة، أنا عايشة بفرنسا، بس اللي عاطي معنى لحياتي هو التزامي السياسي بلبنان". في المقلب الآخر، لحياتها في فرنسا وجود ماديّ، فهي تأكل وتشرب وتعمل وتختبر لحظات من السعادة والتسلية: "يمكن هيدي الحياة ونحنَ محمّلينها زيادة".
تُعدّد المكاسب واحدًا تلو الآخر. منذ انتقالها إلى فرنسا، اكتسبت خبرة مهنيّة واستقلالية، وقدرة على استشراف المستقبل، وأفقًا أوسع لفهم العالم، وأشكالًا جديدة للاستهلاك والمرح والعَيش. تُعدّد الخسائر أيضًا، كالأيام التي تمضيها بعيدة عن والديها بينما يتقدمان بالعمر، وانسحابها بالتالي من حياتهما اليومية، لكنها ترفض أن تضع الأرباح والخسائر في كفتي الميزان، لا لأن الأرباح والخسائر لا تُقارَن فحسب، بل لأن الخسائر التي تتكبّدها يوميًا أثْمَن من أن تُقاس أصلًا.
ربما تكون القدرة على التأقلم بسرعة ميزة خاصة باللبنانيين، وربما لا. تلاحظ عُبيدة أنّ بعضهم يهاجر بخفّة، بلا حسرة. في المقابل، سمعت أحدهم يقول يومًا: "اللبنانيين بيعيشوا تلاتين وأربعين وخمسين سنة ببلد تاني وبيموتوا بهيدا البلد وهنّي بعدهم مفكّرين إنو بيوم من الإيام رح يرجعوا عَ لبنان".
وين بدّك تموتي؟
"أوف، لأ، بدي موت بلبنان أكيد". تجيب بسرعة وبلا تردّد. تفكّر في الموت على أنه لن يحدث لها قبل عمر طويل. في النهاية، يموت الإنسان حيث يبني لنفسه حياةً ويؤسس عائلةً وينجب أطفالًا. مع ذلك، تخاف من الموت في فرنسا: "مع إنو بكون متت وبطلّت إتأثّر، بس كتير بخاف من إنو بس موت ما يكون في حدا بالعزاء، أو شوية أصحاب، مش متل الدفن بلبنان، في مئات الناس. كتير بخاف موت هيك".
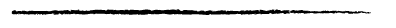
التقيتُ سهى عيتاني يوم السبت 11 حزيران/يونيو 2022 في بيتها الصغير في تولوز. جلست على كرسيّ قرب نافذتها المطلّة على حديقة صغيرة وسماء واسعة، وجلست هي على طرف سريرها. بيني وبينها هاتفٌ ذكي استخدمته لتسجيل الصوت وحديث دار بيننا لساعتين من الزمن. التقطتُ صورتين فوريّتين لها، وصورتين إضافيّتين للبيت.

بَكَت سُهى عندما قالت لها جارتها في بيروت: "منيح إنك تركتِ كل شي ورا ضهرِك وفَلّيتي". بعد هجرتها إلى فرنسا، وفي إحدى زياراتها للبنان، دارت مشادّة كلاميّة بين ساكني إحدى شقق البناية وعائلة الناطور. كانت ابنة الجيران التي تتخصص في التمريض عائدة إلى بيتها بعد يوم عمل طويل. أثناء صعودها الدرج، وقعت في الطابق الثالث. قعدت على سفرة الدرج، واتصلت بوالدتها التي اتصلت بدورها بابن الناطور وطلبت إليه أن يشغّل مولّد الكهرباء الخاص بالبناية لدقائق قليلة ريثما تصل ابنتها إلى شقتهما في الطابق التاسع باستخدام المِصعد، لأن التيار الكهربائي كان مقطوعًا.
رفض ابن الناطور طلبها متذرّعًا بأنّ والده نائم. فورًا، احتدم الشجار بين العائلتين، وتوافد الجيران على أثره إلى الردهة، محاولين فضّ الخلاف وتهدئة الأجواء. وسط هذه البلبلة، وجدت إحدى الجارات الوقت مناسبًا للثناء على قرار سهى بالهجرة. اقتربت إليها وقالت: "هيدا لَتَعِرْفي إنو منيح إنك تركتِ كل شي ورا ضهرِك وفَلّيتي".
كانت الجارة تقصد بكلامها أنّ البلد أصبح مكانًا غير قابل للعيش، مُستندة في خلاصتها إلى أنّ الجيران أصبحوا يتشاجرون لأسباب لا تستأهل المشاجرة، كانقطاع التيار الكهربائي وتشغيل المولّد. لم تفهم الجارة ما الذي، في جملتها البسيطة، جعل سُهى تبكي. في الحقيقة، كلّ شيء في جملتها البسيطة يستدعي البكاء، لأن سهى غادرت البلاد فعلًا، ولأنها لم تترك كلّ شيء، وأكثر بعد، لأنها لم تترك كلّ شيء وراء ظهرها تحديدًا. أجابتها بالجملة البسيطة نفسها، إنما بصيغة النفي: "لأ، ما تركت كل شي ورا ضهري ومْشيت. في حياة هون".
انتقلت سُهى من بيروت إلى مدينة تولوز في فرنسا في آب/أغسطس 2020 للالتحاق ببرنامج دكتوراه في مجال التسويق في إحدى جامعات المدينة. غادرت مصمّمةً على أن يكون رحيلها نهائيًا. لا عودة عن قرارها بعد مرور سنتين على هجرتها. على العكس تمامًا، تخاف من أن تضطر إلى العودة إلى لبنان، لكنّ قرارها بعدم الرجوع إلى بلدها لا يعني أنها تركت كل شيء وراء ظهرها ومشت. "لبنان عمر"، تقول سهى لاختصار ما سبق. غادرت إلى فرنسا بعمر التاسعة والثلاثين سنة إلّا أسبوع. تشدد على الرقم. تسع وثلاثون سنة؛ أي حياتها كلها. "لبنان، خراب مش خراب، فساد مش فساد، موجود فيي"، وتضيف للتأكيد: "حتى لو فلّيت وحتى لو ما بدي إرجع".
مثل معظم اللبنانيين الَّذين غادروا البلد أو الذين يحلمون بالهجرة، سعت سُهى وراءها للأسباب البديهية ذاتها، وأوّلها أنّ البلد مُتعِب. انتظرت سنتين كاملتين قبل أن تُقبَل في برنامجٍ في تولوز، اتّضح لاحقًا أنه الأكثر ملاءمةً لتطلّعاتها، لأنه يتضمن سنة أولى تمهيدية، لكن مشكلة البرنامج أن هذه السنة كانت غير مدفوعة، وأنّ التأهل إلى السنة الثانية مشروط بالأداء، وبالتالي لم يكن مضمونًا. كانت سهى مصمّمة على الهجرة، فقرّرت المجازفة. أمّا كلفة التعليم والمصاريف التي لم يكن لديها المقدرة على تأمينها، لأنها لم تتمكّن يومًا من الادّخار، فيموّلها تعويض نهاية الخدمة الّذي يكفله لها صندوق الضمان الاجتماعي، والذي يفترض أن يوازي عشرين ألف دولار.
تمكّنت سهى من الحصول على تعويضها بعد أخذ وردّ، ولكن يومها، وبسبب تدهور قيمة الليرة اللبنانية، لم يساوِ سوى ألفَي دولار، أي أنه خسر أكثر من 90% من قيمته. "هيدا مش سبب كافي حتى الواحد يفلّ من البلد؟"، تسأل سهى. تواسي نفسها بالمقارنة بين مآسي الناس ومآسيها. سمعت عن ناس خسروا بيوتهم وحياتهم وأهلهم وتعويضات 50 سنة من عملهم. أمّا هي، فلم تخسر كثيرًا مقارنة بهم، ثم إنّها وجدت وظيفة في الجامعة، وموّلت من خلالها عامها الأول. تقول: "الله عوضني".
إلى جانب هذه الدوافع، أصرّت سُهى على الهجرة لأنها كانت ترغب بشدّة في أن تختبر العيش وحيدة، بعد أن أمضت حياتها كلّها في منزل العائلة. بسفرها إلى فرنسا، تحقّقت أمنيتها، لكنها خسرت أن تكون مُحاطة بأشخاص تحبّهم وتحبّ لقاءهم، سواء الأهل، أو الإخوة، أو الأصدقاء، أو الأصدقاء في مكان العمل.
لم تكن تعرف أحدًا في تولوز. صارت تتعرّف "من أوّل وجديد"، لكنّ الانتقال إلى مدينة جديدة في بلد جديد في عمر متقدّم لا يسهّل العمليّة، بل يصعّبها. تفكّر في عمرها، وفي أنّ الذين يهاجرون بعمر الثامنة عشرة مثلاً لا يسيرون في المدينة مثقلين بالذكريات مثلها، وبقصص مدينة أخرى وعائلة بعيدة وحياة سابقة. تفكر أيضًا في أن تولوز مدينة جامعية. لذا، يَسهُل على اليافعين فيها أن يبنوا صداقات ويصنعوا لأنفسهم دائرة صغيرة من الأصحاب يكتشفون أنفسهم ضمنها وتتشكّل فيها وحولها شخصيّاتهم.
في أحد الصباحات، فتحت سُهى شبّاك بيتها في تولوز المطلّ على حديقة، وتحضّرت لممارسة التمارين الرياضية الصباحية، لكنّها لم تجد الحماسة الكافية لتبدأ التمرين. مرّت حمامة أمام شبّاكها، فتذكرت فجأة أغنية ريمي بندلي التي تقول فيها: "طير وعلّي يا حمام فوق سطوح بيوتنا". استمعت إليها طوال فترة التمرين، وانتبهت إلى أنّ تولوز فيها حمام كثير، لكن حمام هذه المدينة يذكّرها بحمام بيروت. تشتاق إلى هذه الأمور التي تصفها بالبسيطة؛ إلى كشّاش الحمام على مقربة من بيتها في الزيدانية، وإلى صاحب الدكان الذي يستقبلها كلّ مرة بـ"أهلا وسهلا" و"اشتقنالك عمّو"، وإلى الشوارع الضيقة في المنطقة الشعبية التي كانت تسكنها.
تتذكّر اقتباسًا للكاتب المصري أحمد خالد توفيق يعينها على التعبير: "وطنك هو المكان الذي ارتديت فيه أول سروال طويل في حياتك، ولعبت أول مباراة كرة قدم، وسمعت أول قصيدة، وكتبت أول خطاب حب، وتلقيت أول علقة من معلمك أو خصومك في المدرسة... وطنك هو المكان الذي ذهبت فيه إلى المسجد لأول مرة وحدك، وخلعت حذاءك متحدّيًا صديقك أن يقف جوارك لتريا أيّكما أطول قامة... وطنك هو أول مكان تمرّغت على عشبه في صراع مع صديق لدود من أجل فتاة لا تعرف شيئًا عن كليكما".

لطالما أرادت سُهى أن ترحل. كان الناس حولها يسألونها باستمرار: "عنجد بدّك تفلّي وتعيشي لحالك؟ إنت مِسْتهِوني بالعيشة لحالك؟". أرادات أن ترحل، ولم تفكّر في شيء سوى الرحيل. عندما انتقلت إلى فرنسا، فهمت مقصدهم، وفهمت أكثر موقف المغتربين ونقلهم التجربة. لم تكن تعلم أن تغييراً من هذا النوع يترافق مع تحديات بهذا الحجم. أرادت سُهى أن ترحل، لكنها تقول، كما لو كانت طفلة صغيرة تشرح خياراتها لراشدين ينتظرون منها تبريرًا: "كان بدي إجي بس ما كنت بعرف إنو هيك"، لكنها تعود وتفكّر في أن الحياة اتزان، أي أنها لا تقدّم شيئًا من دون أن تأخذ شيئًا آخر. تحقّقت أمنية سُهى بالرحيل، لكنها تفكّر في أنه ربما كان من الأجدر بها أن تحذَر ممّا تتمنّاه، كما توصي العبارة الشهيرة، لئلا يحصل فعلًا: "دايمًا كنت قول إنو بدي فلّ لأن عبالي عيش لحالي بس ما كان قصدي إنو عنجد كون لحالي. ما كان هيك قصدي. كان قصدي شي تاني".
بعد مرور بضعة أشهر على انتقالها إلى فرنسا، توفيت سُهيلة، والدة سُهى، بعد صراع مع المرض. عندما أصيبت بالسرطان، اعتقدت سهى أنّها ستتلقى العلاج وتتعافى وتزورها في مدينتها الجديدة تولوز، لكنّها توفيت قبل أن تتسنى لهما فرصة اكتشاف المدينة معاً.
في شقتها الصغيرة في تولوز صور كثيرة لأمها؛ بعضها يزيّن الحائط، وبعضها الآخر معروض على رفوف المكتبة، وأخرى في إطار موضوع في زاوية فوق وسادة السرير، إلى جانب مصباح وأزهار لافندر. تعيش سُهى في بلاد لا تعرفها أمّها، في أماكن غريبة تمامًا عنها. تزور لبنان كلما سنحت لها الفرصة، لأن بيتها في بيروت يعني أمّها، ولا تزال رائحتها فيه. تزور خالات أمّها، لأن أمها كانت تحبّ خالاتها، وتزور أخوالها، وتزور عمّتها أيضًا التي أحبّت أمّها كثيرًا. تزور والدتها في المقبرة. يؤلمها في هجرتها أنها لا تزورها يوم عيد ميلاها، ولا في الأعياد، إلا إذا كانت في زيارة لبيروت حينها.
تعتقد سهى أنّ قلّة من الناس تفهم فعليًا ماذا يعني أن يعيش الإنسان وحيدًا في المهجر، وأكثر بعد، ماذا يعني أن يعيش الحداد في الغربة. في أحد الأيام، شعرت بوحدة كبيرة، إلى درجة أنها كادت تفقد عقلها. يومها، بحثت في محرّك غوغل عن جمعيّات تقدم المساعدة للأشخاص الذين فقدوا عزيزًا. تواصلت مع جمعية رافقتها في حدادها طوال سنة كاملة. تنسى سهى في بعض الأحيان أنها تعيش في مكان جميل جدًا. عندما تنتبه إلى ذلك، تخرج لتمشي على ضفاف النهر أو تتمدد على العشب في الحديقة. تقول لنفسها: "عيشي هون!".
وين بدك تموتي؟
لا يهمّها أين تموت. يهمّها أن تُدفن فوق قبر أمّها. سواء عاشت في فرنسا أو في أي دولة أخرى. تريد أن تُدفن فوق أمّها. دُفنت أمها فوق والدتها ووالدها وأخيها، وهي ستدفن فوقهم كلهم. لا تعرف إذا كان لأيٍّ من هذا معنى، لكن الموضوع غير قابل للنقاش بالنسبة إليها.
سواء عاشت ما تبقّى من حياتها في لبنان أو خارجه، تريد أن تُدفن في أرضها، لأنها تعتقد أنّ الأمر طبيعي بالنسبة إلى شخص عاش ما يقارب 40 سنة في لبنان. ولكن ماذا لو عاشت السنوات الأربعين المقبلة في فرنسا مثلاً! هل تُدفن في فرنسا عندها؟ تهزّ رأسها: "أمّي مش بفرنسا".
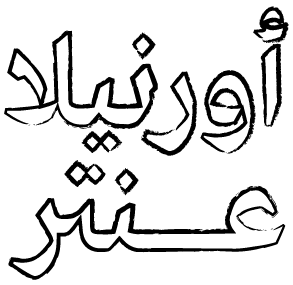
Loneliness. Because this is how it feels. I'm living in a house with my son who moved with me. I'm divorced and I never felt lonely when I was in Lebanon as I had my small circle of friends who added a lot of joy to my life. My parents were in a different city but I managed to drive to their house every time I felt that I need them. Here, the only people around you are your friends who have a different culture and are not used to people calling them any time to just talk about what bothers them as you do in Lebanon.
الغربة فعلا هي تربة، بتدفنك إنت وواعي، بتمرض وحدك، بتبكي وحدك وبتضحك وحدك وبتضارب وحدك، بتيأس وحدك. بدك توقف وتؤسس وتشقى وحدك. حياة الغربة صعبة وخصوصي عَ اللي معوّد يعيش بين ناسو وأهلو. إسمك مغترب يعني غريب ولو صار معك بطاقة أو إقامة، بتبقى غريب والغربة أكبر كذبة: كل سنة بتقول هيدي آخر سنة وكل ما ها السنين بتجرّ بعضها و بتطلع بعدان بتلاقي حالك مرقت وقت وهالوقت هو من عمرك
يقول نجيب محفوظ "وطن المرء ليس مكان ولادته ولكنه المكان الذي تنتهي فيه كل محاولاته للهروب". وها أنا اليوم، أجد نفسي مشتتة بين لبنان الذي هربت منه عام ٢٠١٧ وتركيا التي احتضنتني وأنا ابنة ٢٣ عامًا وشعرت فيها بالاستقرار والأمان. ولكنني أتساءل دومًا: هل يكفي للوطن أن يكون مكانًا صالحًا للعيش؟ أو لا بد أن يكون هناك من ينتظرك فيه؟ فشعور الوحدة في الاغتراب… لا يُطاق!