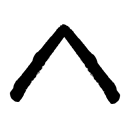انتبهتُ للتلفزيون في الغرفة فجأة كأنني أراه للمرة الأولى. فكّرتُ فيه كأنّه فكرة. فكّرتُ في التلفزيون في غرفة المعيشة في بيت العائلة. لم أكن هنا أفكّر في تلفزيوننا في بيتنا نحن، بل في كل التلفزيونات في كل البيوت. ماذا لو لم نكن وحدنا نتفرّج عليه؟ ماذا لو كان هو أيضًا يتفرّج علينا؟ ما الذي يراه يا ترى؟ وكيف نبدو أمامه؟ هل "نتجرّس" أمامه مثلًا؟ هل يعرف أسرارنا، أو يأسف لحالنا، أو يتفرّج علينا بحنو؟ هل يخجل عندما نقبّل بعضنا بعضاً على الكنبة أمامه أو يشعر بالحرج إذا تشارعنا؟
التلفزيون في غرفة المعيشة هو المدخل إلى موضوع العدد الثالث من مجاز، لكنّ موضوع العدد هو العائلة نفسها التي تتحرّك وتتفاعل ضمن هذه المساحة المشتركة، والعائلة، في هذا السياق، تشكّل كائنًا قائمًا بذاته، وتتعدّى كونها مجموعة من الأفراد، فهي أكبر من مجموع أفرادها، وتختلف بالتالي عنهم.
يمكننا أن نفكّر في المسألة على الشكل الآتي مثلاً: في هذا البيت يعيش أبٌ وأمّ، وأخ وأخت، وعائلة. كيف تشتغل ديناميكية العلاقات بين أفراد هذه العائلة الواحدة في غرفة المعيشة؟ وكيف تتوزّع السلطة ضمن هذه العلاقات؟ وكيف ترعاها؟ تتجلّى السُلطة، بشكل عام، على مستويين؛ المؤسَّسي واليَومي. تهتمّ مجاز بالمستوى اليومي الذي غالبًا ما يعدّه الصحافيون والباحثون ثانويًا وأقل أهمية من غيره. إضافةً إلى ذلك، يؤدّي إهمال الجوانب "العادية" للحياة اليومية إلى تعزيز النخبوية العلمية وتجاهل تجارب الناس. يعدّ التلفزيون مكوّنًا أساسيًا من الحياة اليومية، والتطرّق إليه يوفّر، بالتالي، نظرة ثاقبة إلى جوانب اجتماعية أشمل.
تهتمّ مجاز في عددها الثالث بالتلفزيون باعتباره عنصرًا مكوّنًا للحياة اليوميّة وللبيوت، وتتناوله باعتباره غرضاً قائماً بذاته، لا باعتباره وسيطاً فحسب؛ ففي معظم المرّات التي يتمّ فيها التطرّق إلى التلفزيون كموضوع أو كمادّة للدراسة أو للنقاش، تكون المقاربة متمحورة حول تأثير المحتوى في المشاهد الذي ينظر إليه على أنّه عنصر متلقٍّ لا حول له ولا قوّة.
في هذا العدد، تعالج مجاز مسألة حضور التلفزيون في البيت، وتحوّله مع الوقت إلى فرد من أفراد العائلة يُساهم وجوده في ترتيب أثاث البيت باتجاه معيّن، وفي تنظيم وقت النوم ووقت الراحة واللعب، وأدائه دور الشاهد على حيوات الناس في بيوتها.
نبحث في كل الوظائف التي يؤديها التلفزيون باستثناء الوظيفة الأساسية التي صُنع من أجلها: مشاهدة البرامج. نفكّر في استخدام الأسرة للتلفزيون، وكيف تبني كلّ منها معنى خاصًا بها للتلفزيون داخل المنزل، باعتبار أنّ أسلوب الحياة الذي ينشأ حول مشاهدته لا يأتي من العدم، فهو دائمًا ما يشير إلى أنماط سُلوكية أكثر تعقيدًا داخل العائلة الواحدة. من جهة أخرى، نتذرّع بالتلفزيون للتحدث عن العائلة، ليكون لنا عذر لطرح هذا الموضوع الذي غالبًا ما تتمّ مناقشته إمّا في عيادات المعالجين النفسيين، أي خلف أبواب مغلقة، وإمّا في سياق المديح والتبجيل وتقديس العائلة، ونادرًا ما نناقشه في سياق التفكير فيه ومحاولة تشريحه واتخاذ مسافة منه: التفرّج عليه.
تتّبع مجاز في هذا العدد، كما في باقي الأعداد، أسلوب السرد الصحافي الأقرب إلى أدب الواقع، لكنّها، خلافًا للأعداد السابقة، تنطلق هذه المرّة من وجهة نظر مختلفة تمامًا هي وجهة نظر التلفزيون، وهي غاية تتحقّق من خلال شخصنة الجهاز الذي يؤدي دور الراوي في كلّ من النصوص التالية.
خلافًا للأعداد السابقة أيضًا، أقامت مَجاز ورشة كتابة استمرّت ثمانية أسابيع مع ثلاث قارئات لمجاز، أصبحنَ، هذه المرّة، كاتبات فيها، هنّ: نهى وزهراء وميساء. التقيتُهنّ ساعتين أو ثلاث ساعات كلّ نهار أحد للتفكير معًا في الموضوع، ولتعلّم أسلوب السرد الصحافي والكتابة الإبداعية وكيفيّة كتابة أدب الواقع. خلال هذه الجلسات، استمعتُ لهنّ وهن يتحدّثن ويدخلننا بيوتهنّ وغرف المعيشة في بيوت عائلاتهنّ من خلال شاشة التلفزيون، لتكتب كلّ منهنّ قصّتها بنفسها.
في إحدى قصص العدد، تروي نُهى قصتين: قصّة تلفزيون قديم كانت عائلتها تنقله من غرفة الجلوس إلى المطبخ وقصّة تلفزيون جديد اشتروه بعدما ابتدعوا غرفة جلوس جديدة. في قصّة أخرى، تروي ميساء لنا سيرة صبحيّات نهار الأحد بعيون تلفزيون المطبخ الذي يسمع الكثير عن والدها ولا يكاد يراه أبدًا. أمّا في القصة الأخيرة، فتروي زهراء أسراراً لا يعرفها سوى التلفزيون؛ الشاهد الوحيد على كل جوانب قصص عائلتها التي يتناقلها أهل البيت باجتزاء وبالسر عن بعضهم بعضاً.
هذا العدد هو دعوة للغرق في العنصر الأكثر يوميّة في حياتنا اليومية، أي التلفزيون، وفي العائلة التي تتشكّل حوله بحسب أهوائها وخلفياتها وتوزّع المقاعد والسُلطة بين أفرادها: من يتحكّم في جهاز التحكّم عن بعد؟ من يجلس مقابل الشاشة؟ من يخلد إلى النوم قبل نشرة الأخبار؟ هذا العدد هو عدد تجريبيّ، سواء لناحية الموضوع، أو لناحية شخصنة التلفزيون ليحتلّ مكان الراوي، أو لناحية كتابة قارئات مجاز نفسهنّ في أعدادها.
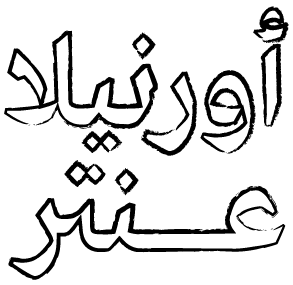
"طلعولي هالتلفزيون عالتتخيتة". سَمعتُها تقول هذه الجملة من دون أن يرفّ لها جفن. للوهلة الأولى، أردتُ أن أصرخ وأذكّرها بأنني تحمّلت العيش بينهم سنين طويلة ولم أفتح فمي. حسنًا. ربما فتحت فمي قليلًا، لكنّني تأخّرت. من يصغي الآن إلى تلفزيون عتيق؟
لم يبدِ أحد اعتراضًا على هذا القرار؛ لا نهى ولا جيسيكا ولا سعيد. لم يحاول أحد منهم أن يتوسّط لي معها أو يذكّرها بالخبز والملح الذي بيننا. لا عتب عليهم. ربما يحاولون الهرب باتجاه النسيان وأنا أذكّرهم بالماضي.

في الماضي، كنت أجلس مع الأولاد في غرفة يسمّونها "الدربية". ليست لديّ أدنى فكرة عن سبب تسميتها بهذا الاسم. غرفة تتوسّط غرف النوم تحوّلت إلى غرفة جلوس. يجتمعون فيها بعد عودتهم من المدرسة. فيها مكتب وكرسيّ مخصّص للواجبات المدرسيّة المكتوبة، وفيها مقعد خشبي كبير ومريح للواجبات التي لا تطلّب كتابة، كالقراءة والحفظ، وفيها أيضًا سجّادة لمن يفضّل التمركز على الأرض. أمّا أنا، فتشاركني الزاوية "دفّاية غاز" تتألف من ثلاث عيون، يشغلونها كلها فور دخولهم الغرفة، ثم يطفئون عينًا أو اثنتين منها بعد أن تصبح دافئة.
يمرّ الوقت بعد الظهر ببطء بين الدرس والتسميع. تدخل ماري، أمّهم، إلى الغرفة وتخرج منها كل بضع دقائق لتتأكّد أنّ كلًّا منهم يقوم بواجباته. أمّا إذا كان لديها تصحيح أو تحضير للمدرسة، فتجد لنفسها مكانًا بين الأولاد في "الدربية". وعندما ينتهون من إنجاز فروضهم المدرسيّة، يصبح بإمكانهم أخيرًا تشغيل التفلزيون، أي تشغيلي أنا. أمّا إذا تأخر أحد الإخوة في إنجاز فرضه، وأخّر معه بالتالي موعد تشغيلي، فإنهم يبدأون بالتأفّف ليعلم أنّ "خلقهم ضاق" وليشعر بالذنب. موقف لا يُحسد عليه.
يبدأ "ميني ستوديو" فتنفرج أسارير الأولاد. هذا هو الوقت الذروة؛ وقت المرح والراحة. تأخذ فيه نهى استراحة من قلقها. لا أعرف إذا كان من الطبيعي أن يسيطر شعور القلق على الأولاد، لأنّني لم أرَ في حياتي أولادًا غيرهم. كيف لي أن أعرف؟ لكنّني أظنّه أمرًا غير طبيعي. قلق نهى، الأخت الكبيرة، كان قلقًا حقيقيًا. يطوف على وجهها كقلق الكبار. كنت أرى غيمة سوداء فوق رأسها تلحق بها أينما ذهبت كأنها في فيلم كرتون. غيمة تتلبّد كلما كان الجوّ في البيت مشحونًا. ماذا يسمّون هذا الشعور الذي يرافق الأخت الكبيرة؟ ليس شعورًا بالمسؤولية بقدر ما هو رغبة في أن تكون معطفًا لأختها وأخيها.
كلّ يوم، عندما تُشرف حلقة "ميني ستوديو" على الانتهاء وتبدأ فقرة قراءة الرسائل البريدية التي يرسلها المشاهدون إلى البرنامج، يعرف الأولاد أن والدهم سيعود قريبًا من عمله إلى البيت. أرى نُهى أمامي كأن المشهد حصل البارحة. تنتظر أن تُقرأ رسالتها. كانت قد كتبت رسالة وحرصت أن تبدأها باسمها: "أنا نهى"، كي يسمعها العالم كله. سلّمت الرسالة لأهلها، لكنها لم تكن تعرف حينها أنهم لم يرسلوها إلى البرنامج. ظلّت نهى تنتظر. لا عجب في أنّها كبرت وأصبحت تتقن الانتظار. كنت أعرف أنّ الرسالة لم تُرسَل، لكنّني تلفزيون، لا يسمع لي أحدٌ. الكل يريد أن يرى وأن يسمع من خلالي. لديّ الكثير لأقوله عن أهل هذا البيت، لكنّهم لا يريدون أن يسمعوا، والدليل أنّهم وضعوني الآن على "التتخيتة".
بعد الانتهاء من عرض البرامج المخصصة للأولاد، كانت شارة الأخبار تنبئهم بحلول وقت النوم. أمرٌ مفروغ منه لا يحتمل السؤال ولا الجدل. هكذا تمضي أيام الأسبوع. في عطلة نهاية الأسبوع، كان والدهم الملقّب بالمعلّم، نسبة إلى احترافه مهنة النجارة، يحملني وينقلني من زاويتي في "الدربية" إلى المطبخ، حيث كنت أصنع لهم غرفة جلوس ثانية. أليس غريبًا أن تكون أمّهم هي المعلّمة في المدرسة، لكنّ والدهم هو الملقّب بـ"المعلّم"، حتى إنني لم أسمع أحدًا ربما يناديه باسمه الحقيقي: باخوس؟
بمساعدة الصوبيا، كنا نجعل المكان آمنًا من البرد والمناوشات التي كانت تدور بين أهلهم. الصوبيا تتكفّل بالدفء وأنا أقوم بمهمّة "الكاموفلاج" لصوت المحادثات الحادّة التي كانت تدور بينهم. بعض الأحاديث لا يجوز للصغار سماعها.
أتمركز في المطبخ على حافّة المجلى، خلفي الباب الذي يتسرّب منه برد قارص في أيّام الشتاء. الويل لمن يخرج من المطبخ ويترك الباب مفتوحًا أو يلمس شريط "الأنتين" ويخرّب الصورة. مراتٍ كثيرة، حين كان الشريط يقع، كان المعلم يندفع إلى تحريكه، مؤكداً أنّه يستطيع أن يحصّل لهم صورة أكثر نقاء، لكنّه، في الحقيقة، كان يزيد الطين بلّة ويخرّب صورة الشاشة، تمامًا كما فعل موته بصورة العائلة.
كم أنا ثرثار! لم تخطئ أمّهم في وضعي في "التتخيتة". تتذرّع بكوني تلفزيونًا عجوزًا، لكنّني أعرف أنهم يريدون إبعادي لأنّني أعرف الكثير عنهم، تمامًا كما يحدث في الأفلام البوليسية: الشخصية التي تكتشف الحقيقة أولًا يجدونها مقتولة صباح اليوم التالي. يريدونني خارج الصورة.
الصوبيا في وسط المطبخ. يضعون فيها البطاطا الحلوة أو الكستناء. يُحَمّص عليها الخبز وتُسَخّن عليها المياه في إبريق لا يتعب. متأهبٌ دائمًا لفنجان قهوة أو شاي. أحيانًا، كانت تُنشَر على جوانبها جوارب سيرتدونها في اليوم التالي ولم تجفّ لشدّة الرطوبة في الداخل والمطر في الخارج.
في عطلة نهاية الأسبوع، يُسمح للأولاد بأن يسهروا وقتًا أطول، فتسقط رهبة شارة الأخبار ويصبح صوت دولّي غانم ألطف. يتحوّل موعد النوم من عقاب إلى متعة. أيّام عزّ أذكرها وأحبّها رغم قسوة بعضها ومرارته. أيّام عزّ قبل أن يأتي تلفزيونهم الجديد ويتصدر غرفة الجلوس الرسمية. أيحسب نفسه ضيفًا؟
تم استحداث هذه الغرفة التي هي في الأساس سطح بعدما تخرّج الأولاد وما عادت الأقساط تثقل كاهل الأهل. كانت حيطانها بيضاء باستثناء واحد يغطّيه الحجر. يتوسطه موقد يعلوه التلفزيون الذكي. يتمركز في صدر الغرفة! متعاليًا على أهل بيته. في أيّامي، كنت في الزاوية أو على طرف المجلى. على الرغم من كل الامتيازات التي حصل عليها من حيث موقعه وطرازه الجديد وشاشته المسطّحة، فقد فشل في لمّ العائلة حوله وخلق شعور الدفء الذي خلقته أنا.
غرفة الجلوس الجديدة، على عكس "الدربية"، مفتوحة على الصالون لاستقبال ضيوف توقّفوا عن التردد إلى البيت بعد موت المعلّم. كان المعلم يجلس قرب بيت النار كل ليلة على الكرسي نفسه. قبل أن يجلس، يحرص على تغطية الكرسي بقطعة قماش كي لا يُملأ الفرش بالنشارة التي تبقى معلّقة على ثياب العمل.
باستطاعته تأمّل النار ساعات من دون ملل. يحمل جهاز التحكّم عن بعد، ويختار برنامجًا ليشاهده. يغفو ممسكًا بجهاز التحكم. يوقظه الأولاد. يطلبون منه أن يخفض الصوت أو يغيّر المحطّة، فيرفض مؤكدًا أنه كان مستيقظًا على الرغم من سماعهم شخيره. كان ذلك يحدث كل ليلة.
كان يتباهى بالحطبات التي يطعمها للنار، وكانت لديه قناعات راسخة لا تحتمل الجدل. كان مقتنعًا بأن الصبيّ – وإن كان الذكر الوحيد في العائلة – لا يمتلك امتيازات تميّزه عن البنات. كان مقتنعًا بأنّ على زوجته أن تكون موجودة في البيت لدى عودته من العمل. كان مقتنعًا أيضًا بأن خشب السنديان يقاوم اللهب لوقت أطول، ويأتي بدفء أكبر، وكانت لديه عادات غريبة أيضًا، كأن يرغب في ارتداء القميص الوحيد الذي يحتاج إلى الكوي بدلًا من عشرات القمصان المكويّة والمعلّقة في الخزانة. قبل كلّ مشوار، كان الأولاد يتوقّعون حلقة جديدة من مسلسل "أي قميص بدنا نلبس اليوم؟". يعرفون تمامًا كيف تبدأ الحلقة وكيف تنتهي.
مات المعلّم. أصبحت غرفة الجلوس باردة رغم توفر الحطب. بقي مقعده شاغرًا فترة طويلة، فإذا ما جلس أهل البيت في الغرفة، أخذ كل منهم مكانه المعتاد وبقي الكرسي الملتصق ببيت النار وحيدًا. يجلسون مع بعضهم بعضًا ولا يتحدّثون. جميعهم بحاجة إلى التحدث في موضوع واحد، وجميعهم يتحاشون التحدث عنه. كلّ واحد منهم يتجنّب ذكر المعلّم لكي لا يذكّر الآخرين به. من نسيه أصلًا؟ يجلسون مع بعضهم بعضًا، ولا يتحدّثون، والنار تلتهمهم. خشب السنديان أفضل منهم في مقاومة اللهب. أنا أيضًا لديّ قناعات وآراء وأفكار خاصّة بي.
مسكين هذا التلفزيون الجديد "اللمّيع". أي أيام يعيشها؟ مات المعلّم. سافرت نهى إلى دبي. سافرت جيسيكا إلى أستراليا. سعيد في البيت، حتى الآن. أمّهم في غرفة الجلوس تنتظر البنات من موسم إلى آخر، وأنا في "التتخيتة"، يأكلني الغبار. أسلّي نفسي بأخبارهم القديمة بعدما توقّفتُ عن بثّ البرامج، وأفكّر في حياة هذه العائلة: لم تكن حربًا، لم تكن سلامًا. كانت هدنة واحدة طويلة.
يرنّ الهاتف. إنّها العاشرة ليلًا. حطّت الطائرة.
أراهم أمامي جالسين حول المدفأة يحاولون افتعال أحاديث لا علاقة لها بما يشغل بالهم حقيقةً، إلّا ميساء وجدّها. الجدّ يحدّق فيّ طوال الوقت محاولًا قراءة المانشيت. أمّا ميساء، فتحسب الدقائق المتبقية لينزل والدها من الطائرة، ويتخطى الأمن العام، ويحضر حقائبه، ويحمّلها على العربة ويجرّها حتى المنعطف الذي يحبس الأنفاس، ثمّ في الممرّ الاستعراضيّ، حيث يقف الجميع ملتصقين بالحافة. كانت ترغب بشدّة في أن تكون هناك كعادتها، قبل خمس سنوات، أي المرّة الأخيرة التي زار فيها لبنان، لكنّها هنا، في المطبخ أمامي. ارتأت العائلة أنّ من الأفضل أن يقلّه أخوه مع عائلته، فهم يسكنون في بيروت، وهذا عمليّ أكثر، لكنّها خمس سنوات. في رأيها، خمس سنواتٍ جديرة باستقبال احتفاليٍّ في المطار، مع باقة وردٍ مثلًا. خيالٌ راودها عدة مرات حين كان الوقت يتمطّط أمام عينيها حتى يبدو غير قابل للانتهاء. باقة وردٍ ومشوار الطريق. كانت ستحبّ ذلك كثيرًا، لكنّها الآن هنا، أمامي.

صارت الأصوات تخفت شيئًا فشيئًا. لم أعد أصغي إلى ما يتحدّثون عنه. أنسحب بذاكرتي إلى إحدى صبحيّات يوم الأحد من الربيع الفائت.
إنها الساعة العاشرة صباحًا. وضعت خدّوج صينيةً على المجلى. سمعتُ وقع الفنجان الأول، ثمّ الفنجان الثاني. توقّفَت قليلًا. أراها تقف على باب المطبخ وتنادي ميساء لتتأكّد ما إذا كانت ترغب في شرب القهوة اليوم. تردّ عليها: "يلّا بيِسْوَى، فنجان واحد بالأسبوع ما بيضرّ". منذ فترة وهي تحاول التوقّف عن استهلاك الكافيين لأنّه ينبّه جهازها العصبيّ، وقد يكون بالتالي محفّزًا لنوبات القلق. في هذه الأثناء، دخل قاسم إلى المطبخ وهو يفرك عينيه، قبل أن تلحق به ميساء. تربّع كلٌّ منهما على كنبة. أضافت خدّوج فنجانًا ثالثًا، وصحونًا ثلاثة للفناجين، ثم وضعت الصينية على الطاولة بين الكنبتين. تحضّر الصينية والفناجين قبل أن تحضّر القهوة في غرفة المونة المجاورة، حيث استقرّ الغاز – جاري – منذ سنوات.
تستطيع خدّوج سماعهما وهما يصبّحان على بعضهما بعضاً. ميساء بصوت من نام عند التاسعة مساءً واستيقظ عند السادسة صباحًا. صوتٌ ثابتٌ ونغمةٌ ممازحة تدلّ على سعادتها برؤية أخيها في البيت بعد أسبوعٍ من الدوامات المتضاربة. يردّ قاسم بصوتٍ ناعس بالكاد أسمعه: "صباحو". يفرك عينيه من جديد محاولًا أن يُصحصِح بعد سهرةٍ طويلةٍ مع الأصدقاء. "أهلين بولادي"، تقول خدوج وهي تضع الركوة على الصينية: "زمان ما شفناكن". جهّزت صحنًا من الفواكه المجففة والجوز واللوز. ميساء تحبّها. أضافت إليه قطعة من الكيك الذي حضّرته في اليوم السابق. قاسم يحبّه، لكنّها، مجدّدًا، لم تحضر فنجانًا رابعًا، ولم تحضر السكّر. انزعج السكّر. نحن الأشياء نحسّ ببعضنا بعضاً. حاتم، سهّل الله غربته، هو الوحيد الذي "يفشّ له خلقه" في هذا البيت.
أرى السكر يراقب المحيط وكلّه أملٌ بأن يتذوّق القهوة من جديد. أسمعه يتأفّف: "كيف يستطيبون القهوة مرّة؟"، ثمّ يضيف عبارة يسمعها كثيرًا في هذا البيت، يردّدونها عن جدّة الأمّ: "الحياة مرّة، والقهوة مرّة؟". جلست خدّوج إلى جانب ابنتها التي باشرت بصبّ القهوة، وأمسكت هاتفها لتتّصل بزوجها كأنّها انتبهت لتوّها أنّ الصينيّة ينقصها فنجان رابع. لم يردّ. تبدأ إذًا صبحيتهم بالأحاديث المعتادة عن العمل، والجامعة، والبلد، والخطط، والأصدقاء.
يرنّ الهاتف. تعيدني رنّة الهاتف إلى الحاضر. تسحبني من ذكرياتي وتعيدني إليهم. يصل فيديو الممرّ الاستعراضي والسيلفي الجماعية إلى "مجموعة العائلة". تباشر الجدة بالتهليلات. يرنّ الهاتف مرّة أخرى. "مشينا، اسألي الحجة إذا بدها خبز من عند أفران شمسين". هذا يعني أنّ رحلتهم من المطار إلى البيت ستطول. دقائق إضافية تزيدها ميساء على العدّاد في رأسها. يحتاجون قرابة أربعين دقيقة ما لم يكن الطريق مزدحمًا. أكّدت الجدّة أنها ستطبخ الملوخية في اليوم التالي. أصرّت على ذلك بالرغم من عدم اعتراض أحد على قرارها. لا مكان للاعتراض أصلًا، فابنها قادم، ولا بدّ للطّقوس من أن تنفّذ بدقّة.
عادت الأصوات لتخفت تدريجيًّا. أعود لأغرق في صندوق ذاكرتي: صبحية الأحد، الساعة الحادية عشرة. رنّ الهاتف. التقطت خدّوج التلفون فورًا. أسمعُها تقول: "إيه عيني، كيفك؟"، ليس "ألو"، بل "إيه عيني، كيفك؟". قبل أن يتسنّى له أن يجيبها، يتحلّق الأولاد أمام الهاتف، كما يتحلّق المخيّمون حول النار. يتمّ تشغيل مكبّر الصوت. "إيه بابا حبيبي طمني كيف الجامعة؟ بعدهن ما قبضوكن يا عيني؟ إن شاء الله ما فيه إضرابات قريبة؟". أعرف هذا الصوت. أسمعه بشكلٍ دوريّ في المطبخ، لكنّني أستصعبُ ربطه بصورة. أراهم أمامي، في حلقة ثلاثية سرعان ما تتشرذم ما إن تُمسك ميساء التلفون وتبتعد شيئًا فشيئاً عن الحلقة.
تتغيّر طبيعة الحديث: من اليوميّات إلى العناوين الكبرى. يناقشان آخر المستجدّات في العالم العربيّ. أسمعه يسترسل في سرد أحداث تاريخية ذات صلة، حتى أنا، خلال إذاعتي نشرات الأخبار، أعجز عن سردها بتلك الطريقة. أيعقل أن يكون الرجل مذيعًا مثلًا؟ لا أعتقد. لو كان مذيعًا، لكان يجلس الآن معي في العلبة، داخل الشاشة، ولعرفته صوتًا وصورة. هو راوٍ جيّد، هذا أكثر ما أعرفه عنه. تفتعل الأمّ سعالًا خفيفًا. اللبيب من الإشارة يفهم. تسلّمها ميساء الهاتف لكي تتمكن من إكمال الحديث مع زوجها.
يرنّ الهاتف. أعود مجدّدًا إلى الحاضر. صاروا في خلدة. تتفقّد ميساء العدّاد في رأسها: بقي نحو نصف ساعة. لحظة، سيمرّون من السعديات أو من وادي الزينة؟ السعديات. نصف ساعة إذًا.
أغرق مجدّدًا في صندوق ذاكرتي. يحمل صندوقي يوميات هذا المطبخ كلّها. أحيانًا، أرغب أن أجرّب غرفًا أخرى. صبحية الأحد، الساعة الثانية عشرة. هذه المرّة، رنّ هاتف ميساء. تردّ عليه ليكملا حديثهما. أراها تجلس متربّعةً على الكنبة بعدما انسحب أخوها وأمّها من الصبحيّة في المطبخ إلى مهامهم في أركان البيت الأخرى. تصغي وهي تنقّل الهاتف من أذنٍ إلى أخرى، صامتةً، محاولةً أرشفة كل ما يرويه في زاويةٍ ما من ذاكرتها. بعد انتهاء العناوين السياسية الاجتماعية، يأتي دور الأخبار الشخصية. أسمعها تذكر شيئًا عن صديقتها وكيف حصل سوء تفاهم بينهما، ولم تحلّ الأمور رغم أنها حاولت التواصل معها أكثر من مرّة، فيأتيها جوابه المعتاد: "الصياد بحبّ السمك، بس لما يروح يصطاد، بيحط للسمكة سمك أو بيحطلها دودة؟".
هذه المرّة لم يحتج إلى تفسير المثل. غريب. كأنّ هناك رزمة من الشيفرات مصمّمة خصّيصًا لهذه العائلة، كلٌّ منها لموقفٍ مختلف. السعال مثلًا، مصحوبًا بابتسامةٍ خفيفة، هو تكتيك لاستعادة الممتلكات. أمّا قصة الصياد، فهي شيفرة خاصّة بلغات الحبّ. أما الشيفرة الذهبية، فهي "حطيتك سبيكر". شيفراتٌ تختصر الأميال وتحلّ محلّ النظرات ولغة الجسد. أعتقد أن فطرتي التكنولوجية وخبرتي في هذه العائلة صارت تسمح لي بفكّها بكل سهولة كلّ مرّة.
يوقظني الهاتف مجدّدًا. صاروا على "الدبية". ربع ساعة إذًا!
لم أعد أستطيع العودة إلى صندوق ذاكرتي. لفتتني الابتسامة العريضة على وجه ميساء. أراها أمامي، بوضوح، تخطّط: سيسهرون الليلة لوقت متأخّر، سيفرغون الحقيبة، سيكون شهرًا مميّزًا، ثمّ أراها تحزن قليلًا: هل تحزن كثيرًا حين يسافر مجدّدًا، بعد شهرٍ من الآن؟ كلّ مرّة، يأتي قلقها من انتهاء اللحظة الجميلة ليبدّد جمال اللحظة، لماذا؟ لكنّها عادت لتبتسم مجدّدًا. هذا الأحد، سيضعون أربعة فناجين على صينية القهوة، ولن ينسوا علبة السكّر. أرى السكّر يبتسم أيضًا.
إنّها الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل. لم يرنّ الهاتف. سمعتُ صوت الزمامير المتتالية من الشارع. "وَصَّل وصَّل!". لم أعد أرى شيئًا ولا أحدًا. من أطفأني؟
أكاد أجنّ. لم أعد أستطيع تحمل هذه "الطوشة". أريد أن أرفع صوتي، أن أصرخ. أكاد أنفجر استياءً وغيظًا. أودّ أن أنتقل من هنا، أن أكون تلفزيونًا عاديًّا لا يسمع ولا يرى، أو أن أجد نفسي ربما في غرفة جلوسٍ أخرى، بيتٍ آخر، بل ربما عائلةٍ أخرى، لكني عالقٌ في هذا القفص الحديديّ. أرغب في أن أحطمه، أن أهشّم إطاره وزجاجه الهش، وأخرج عن صمتي القهري.
أنظر إلى ريم* ونور* تجلسان أمامي على الكنبة وقد علا صوت جدالهما، وأكاد أجنّ من الاستماع إلى الجدال نفسه للمرة الألف. أما زعيق أولاد نور وضجيجهم، فلا يزيد في رأسي سوى الدوار. الألعاب مرمية على السجادة في منتصف الغرفة، وأطفالٌ أشقياء يحومون كالنحل في أرجائها وهم يتصارعون ويلعبون. يعلو صوتهم، يتشاجرون أيضًا، ولا يكفون عن الثرثرة. أشعر بالتوتر من كل هذه الضجة، وأودّ لو أتنفس هواءً نظيفًا. ليت أحدًا ما يفتح باب "البرندة" كي يدخل الأوكسيجين إلى رئتي، أو ربما أستطيع أن أشم قليلًا رائحة الورود التي زرعتها والدتهما في أحواضٍ بلاستيكيةٍ.
لحظة. عائلة أخرى؟ هل قلت هذا لتوي؟ نزلت هذه الفكرة على رأسي كالصاعقة. أحقًا أريد أن أكون رفيقَ عائلةٍ ثانية؟ أفرك عيني، أحاول التنفس بشكلٍ إرادي، أعيد طرح السؤال على نفسي وأحاول الإجابة بصدقٍ ومن دون انفعال. لا. بالتأكيد لا. كنت أهذي. كنت أهذي حتمًا. أريد أن أكون هنا، معهم، لا أريد غيرهم. أنا مستاءٌ فقط.

لا أكاد أكمل جملتي هذه وحديثي مع نفسي، حتى أسمع صوت ضجيجٍ قادمًا من غرفة الأم: "ريم وينك، جيبيلي مكنة الضغط". تسرع ريم راكضة. تحضر آلة قياس الضغط، فيما تأتي أمها وتجلس أمامي على الكنبة. تمدّ يدها، وتلفّ ريم الرباط المطاطي حول زندها. تنضم إليهما نور لترى ما يحدث. الأمّ تسترخي وريم تتوتّر. بدأ قلبها يدق بسرعة. تشعر بالذنب وتؤاخذ نفسها على شجارها اليوم مع أختها. تتبادل الأختان نظرات العتب، هل كان شجارهما هو السبب في ارتفاع ضغطها؟ كان جدالًا عاديًا، يحدث، أقول لنفسي. أختان بفارق عشر سنواتٍ بينهما، إحداهما عركتها الحياة بتجاربها من الزواج والأمومة والعمل، والأخرى في سنواتها الجامعية الأولى، فهل يعقل أن يكون الحديث بينهما انسجامًا تامًا لا شجار فيه؟
"ماما كتير عالي ضغطك، أحسن نروح عالطوارئ". تتطوَع ريم لمرافقتها، ثم تسرع خارجةً من الغرفة لترتدي ملابسها: "معقول تقلنا العيار اليوم؟". تعرف أمها جيدًا. لا تعبّر بالكلمات، لكن جسدها يقول الحقيقة دائمًا.
أسمعهما وهما واقفتان عند عتبة الباب تتحضّران للذهاب إلى الطوارئ. على الرغم من وضع الأمّ الملحّ، فإنّها تشغل بالها بشيء آخر تمامًا. تفكر في سارة*، ابنتها الكبرى، التي قالت إنّها قادمة اليوم من الجنوب لزيارتهم. ماذا لو وصلت سارة ونحن في المستشفى؟ ماذا ستقول لها؟ تعرف حساسية ابنتها جيدًا: "أكيد رح تتسرسب".
ريم مستعجلة وقلقة: "كأنو هلأ وقت تحملي همّ سارة!". أعتقد أنها احتفظت بهذه الجملة لنفسها لأنني لم أسمعها تقولها. أشعر بالاستياء أنا أيضًا، وأوافق ريم في خواطرها، أم كانت هذه جملتي أنا بالأصل! لا أدري. ما أعرفه هو أن هذه عادتها، تثقل كاهلها بحمل بناتها حتى في أكثر أوقاتها ضيقًا، وكأن الأم لا تحمل طفلها في جسدها تسعة أشهر فقط؛ إنها تحمله إلى الأبد.
اتصلت سارة بعد عودتهما من الطوارئ. توقيت اتصالها مناسب للملمة الأمور من دون جهد. "صرت ع طريق المطار، يلا ربع ساعة وبوصل، حطوا الركوة عالنار". بقي الأمر سرًا إذًا؛ سرًّا مخبأ عن فردٍ واحدٍ من العائلة. وعليّ، بحكم أنني عرفته، أن أكتمه أنا أيضًا. شجارٌ وضجيجٌ وأسرار؟ ماذا بعدُ اليوم؟ رنّ جرس الباب ليقطع حبل أفكاري. أتت سارة مع طفليها المشاغبين. استقبلتهم ريم بصينية القهوة، ودخلوا معًا إلى غرفة الجلوس.
ما إن رأى الولدان جدتهما حتى ركضا إليها فاتحين ذراعَيهما. عناقٌ حارٌ تليه حماسة لإخبارها كل شيءٍ في لحظةٍ واحدة: "تاتا، أنا جبت أعلى علامة بالرياضيات". "تاتا وأنا ربحت بمسابقة الفنون اللي عملتها المدرسة". يتسابقان لرؤية علامات التعجب والفخر على وجهها، فتختلط الأصوات والأحاديث. يملأ المكان زعيق الأولاد وضجيجهم. وأخيرًا، اجتمع أولاد نور وسارة في لقاء ينتظرونه منذ زمن. "يا عين"، جهّز نفسك للمزيد من الشقاوة. تحتال سارة عليهم لتصرفهم للعب في غرفةٍ أخرى، فتنظر إليها أمّها معاتبة. "ماما خلينا نشرب قهوة ع رواق مش رح يخلونا نعرف نحكي". توافقها على مضض، فهنّ حقًا بحاجة إلى بعض الوقت معًا بهدوء.
"سارة، كأنك ضعفانة، صاير شي؟". تقول الأم. تتغامز الأختان، وتبدّدان مخاوف أمّهما. تبدي الأم قلقها على صحة سارة. تخاف عليها أكثر من اللازم، ربما لأنها تشكو من مرضٍ وراثيّ ينغّص عليها حياتها بآلامه الحادة التي تزورها بين فترةٍ وأخرى. تشعر بأن ابنتها تركض ما بين عملها المرهق وبيتها وصبييها الشقيين، وتعرف أن هذا الركض هو ما يؤثر في صحتها. لذا، تراها في ترقبٍ وخوفٍ دائمين.
ينتهي الحديث هنا، ولكني أعرف، كما تعرف ريم، أن الحقيقة لا تنتهي هنا. سمعتهما البارحة على هذه الكنبة بالتحديد. كانت ريم تجلس وهي تحادث سارة على الهاتف. أخبرتها أنها قادمة إلى بيروت لزيارة الطبيب، ففحوصاتها الطبية الأخيرة لا تطمئن. لا تكاد سارة تأخذ نفسًا من مرضها الوراثي، حتى يأتي زائر آخر، مرضٌ مناعيٌ، كما يبدو. حياتها ليست مهددةً بالتأكيد... أما راحة بالها، فبلى، لكن هاجسًا آخر يشغل بالها: "ليكي ريم، أنا قلت لماما نازلة ع بيروت عادي زيارة، ما قلتلها إني مريضة وجايي شوف الدكتور، فالقصة بيناتنا، أوكي؟".
أتذكر هذه الجملة جيدًا، أتذكر هذا السر الذي حملته أنا وريم. أقف عنده الآن وأشعر بأني أرتبك. تختلط مشاعري فأغرق فيها، ولا أنتبه إلا وجلسة القهوة انتهت. ها هي نور تصارع أولادها لتقنعهم بأن وقت العودة إلى البيت حان، ولكن كيف ستقنعهم بأنهم سيعودون وحدهم، وأن أولاد سارة سيبقون لليوم التالي؟ تلك مهمّة عويصة. أسمع صوت بكاء الأطفال وصراخهم وعنادهم، لكن الضجة الآن لم تزعجني. لم أعد أرغب في استكمال مسلسل التذمر الذي بدأته صباحًا، ولا أريد أن أشكو أني تعبت من حفظ أسرارهم التي أظن أنها أتعبتهم أيضًا. أشعر بأنني أرغبُ في معانقتهم فقط. لن أسأل نفسي لماذا، فأنا لا أعرف. أنا تلفزيون، ومع ذلك أشعر بأني أريد أن أُسكنهم في داخلي ليعرفوا الحقيقة كاملة، ولو لمرّة. أرتبك مجددًا. هل هي دمعة في عينيّ؟ "بلا دراما يا صبي"، أقول لنفسي.
هل قلتُ عائلة أخرى؟ يا لسذاجتي.
*تم استخدام أسماء مستعارة في قصة زهراء حفاظًا على خصوصية أفراد عائلتها.