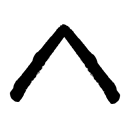تولوز، فرنسا | 17 آذار/مارس 2023
في إحدى المرات، سألت صديقًا لي عاش في إحدى الدول الأوروبية سنوات، ثم عاد للاستقرار في لبنان، عمّا يدفعه إلى البقاء في البلد. انتظرت منه شرحًا طويلًا يوضح فيه أسباب عودته ويعدّها على أصابع يده، لكنه أجابني: "هيدا البلد الوحيد اللي إذا أهله بقيوا فيه، الناس بتسألهم ليش".
أعتقد اليوم أنّني كنت أنتظر منه أن يقدّم لي بقاءه في المكان الذي ولد فيه على أنّه فعل مقاومة: التزام ما تجاه أشخاص يعرفهم بالاسم أو على الأقل بالشكل أو تجاه لغة يتحدّثها بطلاقة، أو شكل من أشكال النضال لئلا يفرغ المكان من أهله.
دحض السؤال من أساسه، ثم أخرج من جيبه سؤالًا جديدًا وناوَلَني إيّاه. وضعتُهُ تحت لساني طوال هذا الوقت: ماذا لو كان بقاء أهل المكان في المكان أمرًا طبيعيًا انسيابيًا كمياه جارية، لا فعل مقاومة أو موضع تعجّب؟
كانت والدتي تتحسّر دومًا على والدتها لأنها لم تغادر مكان ولادتها، ولو لزيارة سريعة أو خاطفة خارج الحدود اللبنانية. كانت تقول – وتؤيدها في ذلك خالتي – أنّ جدّتي "ما شافت شي من هالحياة". كنت أشعر أنا أيضًا بالحسرة عليها، لكنني مع الوقت انتبهت إلى أنّ اهتمامي بهذه العبارة تحوّل، كأنه نزح من بداية الجملة إلى نهايتها. بدلًا من أن أفكّر في جدّتي، صرت أفكّر في الحياة.
كيف تكون الحياة في مكان ولا تكون في آخر؟ بالأحرى، كيف تكون الحياة في كلّ مكان، في أي مكان في العالم، باستثناء المكان الذي ولدنا فيه والذي نعيش فيه أيّامنا؟ ماذا لو كانت الضيعة، أو الحارة حتّى، هي الحياة عند جدّتي؟
يفكّر سميح، في واحدة من قصص هذا العدد، في الأجيال التي سبقت اختراع الطائرة وسهولة السفر: "كيف عاش الناس في مكان واحد قبل أن يصبح السفر متاحًا كما هو اليوم؟ هل كان كلّ منهم يختنق في مكانه وينقصه الهواء؟".
إذا اعتبرنا أن الحياة تكمن في مكان آخر – مكان نحتاج إلى السفر ساعات لبلوغه – فهذا يعني أنّ الحياة ليست حيث نحن، في المكان الذي نعيش فيه يوميًّا، وهذا، في ذاته، أمر محزن للغاية. ما الحياة أصلًا؟ وكيف نحيا وتكون الحياة بعيدة عنّا إلى هذا الحد؟ كيف تكون السعادة هي أيضًا بعيدة إلى هذا الحدّ؟
لطالما سمعنا، في صغرنا، أحدهم يقول إنّ المسافرين أكثر حكمة من غيرهم: "بيفهم كتير، بارم الدني". تنطبق هذه المقولة على المسافرين في زمن لم يكن فيه "العالم قرية صغيرة". كان المسافرون مكتشِفين، وعدد منهم لا يزال كذلك. يغادرون مكانًا مألوفًا إلى آخر مجهول تمامًا، ما يضطرهم إلى بناء معرفة جديدة للتكيّف مع مساحة كانت خيالًا وأصبحت واقعًا. في عالم أصبح كلّه معلومًا لنا، ما نفع السفر؟ يتساءل الكاتب وعالم الاجتماع الفرنسي رودولف كريستان ساخرًا: "ما دام بإمكاننا تناول الهمبرغر في باريس، كما في بكين، فما الفائدة من السفر؟".
عندما انتبهت إلى أنّ عدد سفراتي في السنتين الماضيتين بفعل إقامتي في أوروبا هو ضعف السفرات التي قمت بها في كل السنوات التي سبقت هجرتي، أدركت أنّ السفر الوحيد الذي أحدث في داخلي تغييرًا حقيقيًا هو ذلك الذي قمت به وأنا جالسة على الكرسي في بلدي، أبحث عن ذاتي حيث هي: في داخلي. وفي المرّات التي كنت أبتعد قليلًا في بحثي عنها، كنت أفتّش عنها في البيت الذي كبرت فيه كمن يبحث عن جورب ضائع: سيكون حتمًا في مكان ما على مقربة من الجورب الآخر!
بعض السفر انتقال جغرافيّ للمسافر ليس إلّا. مجرّد تغيير للديكور المحيط بنا، كعائلة تعيسة تعيد ترتيب أثاث بيتها ظنًّا منها أنّ تغيير الديكور قد يغيّر في حالها شيئًا، لتعود وتكتشف لاحقًا أنّها تجلس تعيسة حول الطاولة نفسها، إنما في غرفة أخرى. في قصة أخرى من قصص هذا العدد، تخبرنا رنا أنّها "انتبهت إلى أنّ المغتربين لا يهربون من البلد ومشكلاته... بقدر ما يهربون من أمّهاتهم وآبائهم، ومن حبّ سابق يرافقهم، أو من مشكلات مع الجيران ومع الأقارب والمقرّبين".
إذا كانت وجهة السفر الحقيقية هي الطفولة، المرحلة التي يكون فيها كل جانب من جوانب العالم مصدر اكتشاف ودهشة، فربما لا يتطلّب ذلك تنقلًا جغرافيًا. يكفي أن ننظر إلى العالم بعيون أطفال في متجر للسكاكر.
انتبهت مع الوقت أنّني مسحورة، مذ كنت صغيرة، بالأشخاص الذين يمضون عمرهم في مكان واحد أكثر بكثير من أولئك الذين يجوبون العالم، حتى إنّني، في رأسي، كنت أتوقع من الناس أن تبقى مكانها. أذكر أنّني التقيت يومًا أستاذ الرياضيات أمام صيدلية في بلدتي. بقيت أشهرًا طويلة بعدها ألتفت إليها كلما مررت أمامها لعلّني أجده هناك. وفي كلّ مرّة، كنت أُفاجأ عندما لا أجده قرب الباب، كأن مكانه الطبيعي في الصيدلية. ألم يمرض بعد ذلك؟ لست أدري.
عندما كنت أمرّ بالسيارة مع أمّي أمام المقاهي في تلّ زغرتا، كنت أرى الوجوه نفسها على الكراسي نفسها. في كلّ مرّة، كنت أبحث بين وجوههم عن وجه خالي وصديقه، وأفرح كلّ يوم بلقائه كأنه أتى لتوّه من أميركا مثلًا من دون أن يُعلِمنا. تركن أمّي السيارة على طرف الطريق. نحدّثه لدقائق ثم نبتعد، وأبقى ألوّح له بيدي حتى يختفي المقهى وتختفي الطريق. كلّ يوم أبحث عنه، وكلّ يوم أجده، وكلّ يوم أُفاجأ به.
عندما صرت مراهقة، صرت أقول عن هؤلاء الأشخاص أنفسهم: لا يجدر بهم أن يبقوا في المكان نفسه، وأنّهم، كجدّتي، "ما شافوا شي من هالحياة". أعتقد أنّني كنت أردّد ذلك لأنه يحاكي النزعة العامّة في لبنان والعالم، التي تدفع الناس إلى الاستمرار بالسفر كأنّهم، ما لم يسافروا، يفوّتون عليهم الحياة نفسها.
أعرف اليوم أنّني كنتُ في سرّي مسحورة بالأشخاص الذين لا يرحلون، وكنت أودّ لو أحدّثهم. أودّ لو أسألهم عمّا يشدّهم في كلّ صباح إلى المقهى، عن الأحاديث التي تدور بينهم: ألا تنتهي؟ كنت أودّ لو أسألهم عن التكرار، وعن قدرتهم على الضحك بعد كل هذه السنين، عن قدرتهم على الدهشة أمام المألوف.
في إحدى قصص العدد، تروي "مجاز" قصة ميرا التي تجلس ثلاث مرات في الأسبوع على كرسي في المقهى نفسه على الرصيف المقابل لشجر النخيل. وفي كلّ مرّة، تجد شجر النخيل ساحرًا، فتلتقط له صورة تضيفها إلى عشرات الصور التي التقطتْها في السابق للنخلة نفسها.
في سياق التبشير المستمرّ بالسفر، أيّ سفر، سواء كان بهدف أو من دون هدف، وتقديمه بصفته السبيل الوحيد للنجاح أو للتقدّم أو لمعرفة الذات، تخصّص "مجاز" هذا العدد للتطرّق إلى العلاقة بالمكان المألوف؛ المكان الذي نعيش فيه حياتنا اليومية.
التقيت ثلاثة أشخاص: ميرا وسميح ورنا، كلّ على حدة، وتحدثنا لساعات عن قدرة كلّ منهم على الشعور بالدهشة في الأماكن المألوفة، وعلى النظر إلى العالم من حولهم بعيون غير محمومة. تحدّثنا عن تعريفهم للنجاح الذي لا يتطابق مع التعريفات السائدة، وعن المتعة التي يجدها كلّ منهم في التكرار، وفي البقاء في المكان نفسه؛ المكان الذي عاشوا كلّ حياتهم أو الجزء الأكبر منها فيه.
هذا العدد هو دعوة لتحرير النقاش في أماكن الحياة اليومية، وهو مساحة لإعادة النظر في التكرار الذي يرافق إيقاع الحياة، وفي الركون إليه بدلًا من الهروب منه، وإعادة إنتاجه بالخيال.
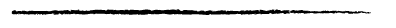
التقيت سميح زَعتر يوم الخميس 13 تشرين الأول/أكتوبر 2022 في زغرتا. تواعدنا عند الساعة الرابعة بعد الظهر في محترفه في حيّ السيدة الغربي، وهو الحيّ الذي يسكنه منذ أن فتح عينيه على الدنيا. خرجتُ من محترفه بعد نحو 4 ساعات. كان الظلام قد حلّ. زرته مرّة جديدة يوم الجمعة 21 تشرين الأول/أكتوبر صباحًا، والتقطت له صورتين فوريّتين.

يقيس سميح الأشياء بالمسافات؛ بالقرب والبعد.
لن يسافر سميح من حيّ السيدة الغربي في زغرتا إلى النيبال في جنوب آسيا ليلتقط صورًا لوجوه الناس، ولن يركب الطائرة ويهبط في بلد جديد ليشمّ الهواء، كأن لا ناس حوله ليصوّرهم ولا هواء ليشمّه! سيبقى في حيّ السيدة الغربي، حيث ورث عن والده – ووالده عن جدّه – محلًّا حوّله في الآونة الأخيرة إلى محترف تصوير.
يلتقط صورًا للأشخاص نفسهم وللأماكن نفسها. يصوّر الأماكن التي يتردّد إليها بانتظام، والأشخاص الذين يلتقيهم في هذه الأماكن وفي الطريق إليها. التكرار موجود، لأنّ المشاهد واللحظات التي تدفعه إلى الحلم تتكرّر أمامه بلا نهاية، لكنّه لا يشبع منها. يصوّرها اليوم بعدما صوّرها أمس، تمامًا كما يتنفّس اليوم مثلما تنفّس أمس، وكما يأكل ويشرب اليوم على الرغم من أنّه أكل وشرب أمس أيضًا.
قبل أن يتحوّل المكان إلى محترف، كان مجرّد خربة. أحبّ سميح المكان في السابق تمامًا كما يحبّه اليوم. "إذا كانت الكَرمة حُلُم بالخمر"**، فالخربة كانت بالنسبة إليه وعداً بمحترف. كانت الأعمال فيه قائمة عندما اكتشف حجرًا ضخمًا لعصر الزيتون مدفونًا تحت الأرض. سأل والده عنه، وتبيّن أنّ المكان كان في السابق معصرة للزيتون، لكنّ الحجر وقع على رأس عمّ والده وقتله على الفور. كان عريسًا جديدًا. على أثر الحادثة، عمد جدّ سميح إلى دفن الحجر تحت الأرض، تمامًا كما دفن أخاه، ثم أوقف عمل المعصرة نهائيًا.
نبش سميح الحجر وأعاده إلى الحياة. صمّم له حُجرة في الأرض تغطّيها لوحة من الزجاج الشفاف يظهر من خلالها بوضوح. وضع الحجر وسط المحترف كمَن يضع الماضي وسط الحاضر. يفكّر في زمن كان فيه الإنسان الأول ينقل ذاكرته إلى أولاده بنحو تلقائي، أي أنّ الأولاد يتذكّرون ما حدث لآبائهم من دون الحاجة إلى نقل الذكريات بالكلام. يضع الحجر وسط المحترف، لأن الحياة استمرارية، ولأنه، ببساطة، ليس غاوي نهايات.
يرتّب سميح الأشياء في محترفه كأن لا بداية لها ولا نهاية. كأنّ كلّ الأشياء في المحترف مثل الحجر؛ كانت موجودة فيه أصلًا: لوحات معلّقة، وصور مسنودة إلى الحائط، وأخرى تسند الحائط، وصور أصغر حجمًا مصفوفة على جهاز راديو، وأخرى خلفه وفوقه. كل الأشياء مرتّبة كأنّ قوّة ما تشدّها باتجاه جدران المحترف، لتبقى كلّها على مسافة شبه واحدة من الحجر. يقيس سميح الأشياء بالمسافات؛ بالقرب والبعد.
في محترفه كُتُب توثّق أعمال مصوّرين كبار "بَرَموا" العالم. يتابع أعمالهم باهتمام، لكنّه ليس واحدًا منهم. ليس مصوّرًا للبعيد. في إحدى المرّات، سافر سميح إلى باريس نحو أسبوعين، وأخذ معه – بطبيعة الحال – الكاميرا، لكنّه وجد نفسه غير قادر على التقاط صورة واحدة!
لم يحرّك المشهد الجديد فيه شيئًا على الإطلاق. بعد مرور 15 يومًا على إقامته فيها، أي قبل بضعة أيام على انتهاء الزيارة، بدأ يشعر بحاجة إلى رفع الكاميرا إلى مستوى عينه. "تبلَّدِت متل ما بيقولوا". تآلف مع المكان، فاستطاع عندها أن يلتقط له صورة. على عكس إحدى مصوّرات الحرب التي تحرص على ألّا تتعدى مدة رحلاتها الميدانيّة أسبوعين، لأن عينها، مع اقتراب موعد انتهاء الرحلة، تكون قد اعتادت المكان، فلا تعود المشاهد حولها – رغم قسوتها – تستوقفها.
كل صباح، يخرج سميح من بيته ويتوجّه إلى المحترف. لا يبتعد كثيرًا، فالمكانَان متلاصِقان. كيفما دار في المحترف، يجد حوله صورًا التقطها لأشخاص وأماكن ولحظات يعرفها جيدًا. أشخاص يعرف وجوههم وأسماءهم، يلقي عَليهم التحية في الطريق أو يشرب معهم القهوة في مقاهي البلدة، حتّى إن عددًا منهم قد يمرّ أمام محترفه في أي لحظة من أيّ يوم عادي. حتّى الأماكن في صوره هي محيطه وبيئته والطبيعة الملتصقة به. لا حاجة له لحجز تذاكر سفر أو تعمّد زيارتها، لأنه غارق فيها أصلًا.
في المساء، يعود إلى بيته. المسافة بين مشوار الصبح ومشوار الليل قصيرة كالمسافة بين بيته والمحترف. هذه "الرَوْحة والمَجْية" هي مساحته للخيال. محيطه ضيّق. ربما يكون ضيّقًا بالفعل، لكنّ أفقه الجمالي والمشهدي واسع. يعلّق على كلامه كأنه انتبه للتوّ لما قاله: "معتّرين نحنَ هون، ما في أفق".
في الحقيقة، ما من شيء يسرّ القلب في هذا البلد. لكنّه سعيد. "مْكَيِّف". لا يمرّ يوم إلا ويكون فيه سعيدًا حيث هو. تنقصه أشياء كثيرة مثل كل المُقيمين في البلد، لكنّه سعيد. في الحقيقة، في العمق، لا ينقصه شيء، لأن السعادة، بالنسبة إليه، تكمن في "الاستمرار برغبة الأشياء التي يملكها أصلًا"***.
يراقب الناس حوله وهم منشغلون في بحثهم المستمرّ عن أشياء لا يملكونها؛ عن التغيير. يسمّونه تجديدًا، لكنه في الحقيقة لا يحتوي على أي جديد، ولا يعِد به أصلًا. يستمع إليهم وهم يتحدّثون عن تغيير الأماكن، وتغيير الملابس، وتغيير الشركاء. يتحدّثون عن السفر كهواية قائمة بذاتها أو كحاجة ملحّة. يستمع إليهم يشتكون من بقائهم في مكان واحد لوقت يعتقدون أنه طويل جدًا: "صارلي والله أكثر من شهرين ما سافرت. رح اختنق".
يستمع إليهم ويفكّر: كيف تكون السعادة أو المتعة في مكان بعيد جدًا عنّا يتطلب وصولنا إليه ساعات طويلة من السفر، ويكون هذا كلّه أمرًا طبيعيًا؟ يفكّر في الحاجة الدائمة إلى العطل، ويستمتع بنبش أصل الكلمة كما نبش الحجر من تحت الأرض: أصل كلمة "عطلة" باللغة اللاتينية هي الفراغ. أن تكون خاليًا. أن ينقصك شيء ما. العطلة حاجة أكبر إلى الفراغ.
يعود إلى الماضي، إلى ما قبل اختراع الطائرة. كيف عاش الناس في مكان واحد قبل أن يصبح السفر متاحًا كما هو اليوم؟ هل كان كلّ منهم يختنق في مكانه وينقصه الهواء؟ يحبّ سميح السفر، لكنّه يفكّر فيه وفي الجدوى منه أكثر ممّا يفكّر فيه الآخرون. هذا مؤكد. يفكّر في السفر بالمطلق، في السفر الفارغ، في السفر "الفاضي". يعود مرّة جديدة إلى زمن قديم كان السفر فيه إمّا استكشافًا للمجهول وإمّا حجًّا، والحجّ، سواء كان دينيًّا أو روحانيًّا أو حضاريًّا، أيضًا استكشاف للمجهول داخلنا. إمّا يكون السفر بنّاءً وإما يكون بلا جدوى: "سطل مَي واندلق عالأرض".

يعرف أنّ الكون فسيح، لكنّه لا يعنيه. يعنيه الرابط الشخصي الذي يشدّه كالجاذبية إلى حيّ السيدة الغربي.
كل صباح، يخرج سميح من بيته إلى بيته الأكبر، إلى حيّ السيدة الغربي، ومنه إلى كل ما هو مألوف لعينه وعدسته. يلتقي الناس في الطريق. يلقي عليهم التحية إمّا بالكلام، وإما بالتقاط صورة لهم، وإما بالاثنين معًا. يحدث هذا كلّه في الطريق. تمشي الحياة ويمشي معها. الدليل على ذلك أن الأشخاص في صوره أحياء. يسيرون في طريق ما. يضحكون أو يعبسون. لا فرق. يحرّكون أياديهم بكل الاتجاهات لترجمة دهشة ما ترافق أحاديثهم في المقاهي، وأمام المقاهي، وفي الدقائق الطويلة التي تسبق مغادرة كلّ منهم المقهى. الساكنون في صوره أيضًا تكون الحركة في رؤوسهم واضحةً في وجوههم. لا حواجز بينه وبين الآخرين في محيطه. لا تتوقف الحياة لكي يلتقط لها صورة.
تمشي الحياة ويمشي معها، لكنّه لا يوثّقها. لو كان يعمل على توثيقها لاكتفى بصورة واحدة لكل شخص، وبلقطة واحدة لكلّ زاوية من المكان، لكنّه لا يبني لها كتالوغًا. لا يعرف كثيرًا ماذا يفعل. بالأحرى، لا يعرف موضوعيًا ماذا يفعل. أمّا ذاتيًا، بعيدًا من الموضوعية، فهو يبحث عن الخيال، عن أبعاد أخرى للشيء الواحد، وأبعاد متجدّدة للشيء نفسه. يعرف تمامًا أنه ليس عنده مكان آخر يذهب إليه – رغم أنّ الكون فسيح – لذا، تكون كل لحظة في محيطه دافعًا للحلم بلا نهاية.
يعرف أنّ الكون فسيح، لكنّه لا يعنيه. لا يقارن بين المكان – محيطه الضيق – وبين كلّ شيء آخر. يعرف موضوعيًا أنّ باريس أحلى من زغرتا: "عالمكفول أنا عم قلك باريس أحلى من زغرتا"، لكنّ هذا أيضًا لا يعنيه. يعنيه الرابط الشخصي الذي يشدّه كالجاذبية إلى قلب زغرتا؛ إلى حيّ السيدة الغربي.
في المساء، يعود إلى بيته الأصغر. زغرتا حلوة لأنه يحبّها، ويحبّها لأنها حلوة، ولا يعرف أيًا منهما يسبق الآخر. لا بدّ من أنهما ظهرتا معًا منذ أن فتح عينيه على الدنيا في بيته؛ في الحيّ نفسه.
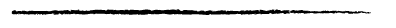
التقيتُ ميرا منقارة يوم الأربعاء 12 تشرين الأوّل/أكتوبر 2022 في طرابلس. تواعدنا في مقهى "ورشة 13" في الميناء. تحدّثنا ساعة كاملة، إذا ما احتسبنا المرّات العديدة التي قاطعَنا فيها أصدقاء التقيناهم بلا موعد، أو المرّات التي طغى فيها صوت محرّك درّاجة ناريّة على صوتنا أو استوقَفَتْنا مشادة كلامية (؟!) بين سائقة سيارة وكلاب داشرة في الطريق. مشينا بعدها على طول كورنيش الميناء، حيث التقطتُ لها وللبحر صورًا فورية.

ترتاد ميرا مقهى "ورشة 13" ثلاثة أيام في الأسبوع على الأقل. تجلس على كرسيّ أمام إحدى الطاولات الأربع أو الخمس على الرصيف المقابل لشجر النخيل. وفي كلّ مرّة، تقول في نفسها: "واو، عنجد شو حلوين"، قبل أن تلتقط للشجرة صورة تضيفها إلى عشرات الصور التي التقطتْها في السابق للنخلة نفسها. تجول في المدينة، وتلتقط صورًا للجوامع وقببها، وللكورنيش نفسه والحمّامات التراثية نفسها، وللسوق وناسها، وللبحر والسماء ذاتها التي تخيّم على المدينة.
تثير طرابلس دهشة ميرا. تدهشها حقًا. ليست دهشة من يرى الأشياء للمرّة الأولى، بل دهشة من يرى الأشياء ألف مرة، ويدهشه في كلّ مرّة أنها لا تزال هنا. تخرج من بيتها. تمشي في شوارع المدينة. تجد بناية تحبّها. تنظر إليها فتشعر بشيء من السعادة، وبنوع من الاستقرار. تشعر بنوع من الـ"شو عرّفني"؛ نوع من الانتماء الذي لا تشعر به أبدًا في أوروبا.
"كل محاولاتي للهروب باءت بالفشل". غادرت ميرا طرابلس مرّتين: مرّة إلى العاصمة التشيكية براغ بين عامَي 2007 و2008 بعد حرب تمّوز، ومرّة أخرى إلى العاصمة الفرنسية باريس بين عامَي 2021 و2022 بعد تفجير مرفأ بيروت.
في السابق، عندما كانت في العشرينات ومطلع الثلاثينات، كان الخارج يُبهرها. كانت تشارك العديد من اللبنانيين اعتقادًا سائدًا بأن أوروبا والأوروبيين مثلًا أكثر فهمًا وتطوّرًا وتحضرًا منهم، لكنها بعدما عاشت في عاصمتين أوروبيّتين، انتبهت إلى أنّ الأمور في الحقيقة ليست كذلك، وأنّ الأوروبيين والغرب، كغيرهم من الشعوب والحضارات، لهم حسناتهم وسيّئاتهم.
ما دام في المكانَين حسنات وسيئات، فضّلت أن تعيش في مكان هو بيت لها، في مكان لا تشعر فيه بالبرد والعزلة. في إحدى المرّات، كانت ميرا مع صديقة لبنانية في شقّتها في باريس التي دامت هجرتها إليها 8 أشهر فقط. سألت ميرا صديقتها: "بتحسّي حالك قادرة تعيشي هون [في باريس]؟". التفتت صديقتها نحو النافذة قبل أن تُجيبها: "ما عندي شي أعطيه هون، ما عندي شي قدّمه هون". أضاءت هذه الإجابة نفقًا من الأسئلة في رأس ميرا: ماذا لديها هي لتقدّمه في باريس؟ هل هذا هو حلمها؟ أن تكون لديها وظيفة؟
تابعت تقدّمها في النفق. في الحقيقة، هربت ميرا من لبنان في المرّتين، لأنها أرادت ببساطة أن تعيش في مكان تشعر فيه بالأمان، فلا تقع قنبلة على رأسها مثلًا، لكنّها، في المقابل، لم تكن تريد أن تعيش في مكان تشعر فيه على الدوام بأن وجودها لا معنى له ولا جدوى. في الغُربتَين، "كان هناك على الدوام غيابٌ ما يعذّبها****". لا تستطيع أن تكون حاضرة تمامًا في الاغتراب. ما إن تحاول الاستقرار في الخارج، حتّى يلتصق بها شعور مستمرّ بأنّ لبنان في مكان آخر، في مكان ليست فيه. أمّا عندما تكون في لبنان، فتتلاشى من تلقاء نفسها كلّ الأماكن الأخرى.
كل محاولاتها للرحيل أعادتها إلى طرابلس. تخرج من بيتها لتسير في الشوارع. المدينة هي نفسها، لكنّ ضوء النهار على أشيائها وناسها غير الأمس. مرّات، يكون الطقس مختلفًا. ومرّات، تكون الأحاديث مع الناس في المدينة مختلفة. حتى المساحات. يختلف شكلها وفقًا للأحاديث التي تدور بين الناس فيها. تلتقي أشخاصاً تعرفهم وتحبّهم، ويحبّونها أيضًا. يُسعدها حبّ الناس لها في المدينة. منذ عام 2002، تعمل ميرا مرشدة سياحية. وفي عام 2014، أسّست ما يُعرف بـ"جولات ميرا"، وهي جولات تصمّمها وتقوم بها في مختلف المناطق اللبنانية، أبرزها طرابلس.
أثناء زياراتها المتكرّرة للجامع المنصوري الكبير مع السائحين، التقت عند مدخل المسجد رجلاً عجوزاً سمعه ضعيف يلقّب بـ"البيك". صار يرحبّ بها بحرارة كل مرة، ويرسل إليها القبلات، ويضع على معصمها ومعصم السياح عطراً من زجاجة صغيرة.
إذا صادفها مع سائح واحد، يقول لها: "اليوم بس واحد؟ الله يبعتلك كتيييير". ويسألها: "أيمتَ بدك تتزوجي نفرح فيكِ؟"، فتجيبه: "ادعيلي، ادعيلي"، قبل أن تمضي. على الرغم من أنّ الناس في السوق يأكلهم التعب نتيجة الأزمة في البلاد، تعود من جولتها في المدينة ممتلئة بالحياة والدفء والفرح. ما دام العيش في المدينة يُسعدها إلى هذا الحدّ، فما المانع من تكراره يوميًّا؟
في طرابلس، تجدّد ميرا حبّها للمدينة كلّ مرّة. تكتشفها أو تعيد اكتشافها. تجد في أشياء المدينة جمالية متجدّدة أو معنى جديدًا. يأتي إلى الحمّام التراثي عمّال جدد. تتعرّف إليهم وتستمع إلى قصصهم أو تفتح مع العمّال القدامى أحاديث جديدة.
منذ فترة، اكتشفت أنّ والد الأخوين اللذين تلتقيهما أمام أحد الحمّامات كان صوفيًّا، فتحدثت إليهما عن الصوفية، واستمعت إلى قصص والدهما. رجل آخر جالس في الزاوية يواظب على إعطائها صورًا قديمة. يفرحون بها: "مين هالبنت اللي جايي تسألنا أسئلة وتحدّثنا؟".

هذه هي الشاعرية بالنسبة إلى ميرا: قصص الناس في الشارع. تستمع إليهم، وتنسج قصصهم لتصنع منها تاريخًا سرديًا تنقله للسيّاح الذين ينضمّون إلى جولاتها، ولا سيما الأجانب. تستمتع بكسر الصورة النمطيّة عن لبنان وطرابلس، وعن النساء في طرابلس، وعن الإسلام أيضًا.
غالبًا ما يسألها الصحافيون الأجانب: "ماذا يعني أن تكوني امرأة في الأسواق في طرابلس؟". يستفزّها السؤال: "ماذا يعني؟ لا يعني شيئًا، عادي". لم تجد يومًا صعوبة في العمل في أسواق المدينة لأنها امرأة. على العكس تمامًا، تشعر بأن الناس في السوق يعاملونها بشكل أفضل تحديدًا لأنها امرأة. يقدّمون لها بعضاً ممّا يبيعون في محالهم أو على البسطات. يضحكون لها أكثر. يتحدثون إليها أكثر. يتغزّلون بها أكثر.
صحيح أنّ هذه المدينة أكثر تحفظًا من غيرها، لكن "وإذا؟". هل هذا يعني أنّ الغرب أفضل بالضرورة؟ تغيّر فهم ميرا لهذه الإشكاليّات. تعتقد أنّ أهالي هذه البلاد استُعمروا بكل الأشكال، وعلى كل الأصعدة، إلى درجة أنّهم لم يتمكّنوا من تطوير أنفسهم وحداثتهم، لأنهم لا يزالون، في عقولهم، مستعمَرين لغاية اليوم. لم يعد الغرب يُدهشها. بدلًا من أن تسافر وتجوب بلادًا أخرى، تأتي هذه البلاد بناسِها إليها.
تواصل سيرها في الشوارع وأزقة الأسواق القديمة، وعلى الكورنيش وفي فسحات المعرض. تشارك العلاقة التي تجمعها بطرابس مع زوّار المدينة. تعرّف الناس إلى مدينتها: كيف تعيش، وكيف تأكل، وكيف تعمل، وكيف تتتالى يوميّاتها. تمرّ أمام منزل جدَّيها فتدلّهم عليه. تحدّثهم بشكل عفوي عن الإسلام، لأنهم غالبًا ما يحملون معهم من بلدانهم أفكارًا مغلوطة عن المسلمين. تصحّح لهم. تشرح لهم. تجيب عن أسئلتهم. تبدّد دهشتهم. هي صلة الوصل بين المألوف والمعلوم عندها، والمجهول والغريب عندهم.
على الرغم من وضع البلاد المزري، في هذه المدينة شيء لها. تجلس على الكرسي في المقهى نفسه أمام شجرة النخيل نفسها. يرنّ هاتفها. مجموعتان من السياح ترغبان في الانضمام إلى جولاتها السبت المقبل والسبت الذي يليه. في طرابلس، يأتي الناس إليها كأنهم يبحثون عنها، كما لو كان عندها شيء يلزمهم فتقدّمه لهم.
في الماضي، كانت تفكّر في ما تقوم به على أنّه نوع من الالتزام، لكنها اليوم، تقوم بالأشياء بدافع الحبّ ومن أجله. تقوم بالأشياء التي تعطيها نوعًا من السعادة والسلام والتواصل. تتواصل مع المدينة ومع العالم في الوقت نفسه، من خلال ناس المدينة من جهة، وزوّارها من جهة أخرى. لا تحبّ الالتزام. ليست منقذة المدينة، ولا مسؤولة عنها. هي تحبّها فقط.
تحبّها وتفكّر فيها على أنّها كائن حيّ وصديقة حميمة. لها مع المدينة قصص خاصة تتشاركها وحدها معها: "في قصص بس أنا وياها منعرفهم، بس أنا وياها منحسّهم"، لكنّ هذه العلاقة، ككلّ العلاقات البشريّة، هي علاقة مركّبة. في مراحل معيّنة، تخذلها المدينة أو تثير غضبها. تتشاجر معها، ثم تتصالح معها. "كتير بتوجّع هيدي العلاقة". تقول لنفسها في بعض الأحيان إنّها تودّ لو تحبّ هذه المدينة أقلّ، لو تتعلّق بها أقل. بين ميرا وطرابلس علاقة عمرها 23 سنة، مرت خلالها بمشاعر مختلفة ومتناقضة، إلا الكره. غالبًا ما يتحدّث الناس عن علاقة حبّ وكره لوصف العلاقات المركبة، ولكن إلا الكره. بينها وبين طرابلس علاقة حب وحزن.
عند عودتها إلى لبنان، قوبلت بالكثير من الانتقاد: "وَلَو؟ حدا بيصير معو هيك؟"، لكنها قابلته بحزم: "إيه، أنا هيك صار معي!". تخرج ميرا من النفق إلى الضوء. تعود إلى طرابلس بعدما فشلت في باريس، وقبلها في براغ. يقول الناس إن السفر يجعل الأشخاص يتقدمون، ولكن سفرها إلى باريس أعادها إلى الوراء. ما حصل لها يحدث لكثر: "بس ما حدا بيحكي، ما إلهم عين، لأن مفروض إنو دايمًا برّا أحسن". بعكس ما يروي الناس عن قصص النجاح في الخارج، حققت ميرا النجاح الذي تطمح إليه في طرابلس، وعلى بعد 5 دقائق سيرًا على الأقدام من بيتها.
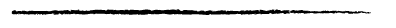
التقيتُ رنا عيد يوم الأربعاء 14 تشرين الأوّل/أكتوبر 2022 في بيروت. قابلتها عند الساعة الخامسة بعد الظهر في الاستوديو الخاص بها الذي تعمل فيه مصمّمة صوت لأفلام ووثائقيات. التقطت لها صورة فورية على شرفة الاستوديو قبل بدء الجلسة خوفًا من أن تكون الشمس قد غابت كلّيًا عند انتهاء حديثنا، وهو ما حصل بالفعل. عُدنا من الشرفة بصورتين: صورة لوجهها، وأخرى للمشهد حولها.

"ما بقا حدا يقلّي إطلع برّات بيروت!". في الرابع من آب/أغسطس 2020، دقائق بعد الساعة السادسة مساءً، وقع انفجار مرفأ بيروت. في تلك اللحظة، وفي الساعات القليلة التي تلتها، لم يكن موقع الانفجار معلومًا بعد ولا حجمه. في هذه الأثناء، وفيما كان الدخان يخنق المدينة والغموض يلفّها، كانت رنا تتلقى اتصالًا بعد آخر من مقرّبين إليها، يستعجلها كلّ منهم بدوره لتخرج حالًا من بيروت، لأنها تعاني من الربو.
عند حدوث الانفجار، لم يكن التفجير نفسه هو مصدر الرعب الذي عاشته، بل الاتصالات المتكرّرة التي كانت تردها بلا توقّف. كان هذا قبل أن تدرك، هي وغيرها من اللبنانيين، حجم الكارثة. عندما صرخت أخيرًا بأحد المتّصلين بها: "ما بقا حدا يقلّي إطلع برّات بيروت! ما بدّي، ما بدّي إطلع"، هدأت. عندها فقط، هدأت وأصبح بإمكانها أن تلتفت إلى الهمّ الأكبر: مين مات؟
ماتت المدينة.
خلال السنتين الماضيتين، تصالحت رنا مع ما تسمّيه موت بيروت وموت البلد. "طيب، ماتوا. شو بعمل فيهم هلق؟". وقفت أمام المدينة كمن يقف دقيقة طويلة أمام برّاد حزين وفارغ من الأطعمة ما عدا مكوّنين أو ثلاثة كحدّ أقصى. أمامها خياران: إمّا تندب حظّها وإما تحاول قدر الإمكان أن تحضّر طبخة شهيّة بهذه المكوّنات المحدودة. أغلقت باب البرّاد بحزم وأشعلت النار. سوف تصنع شيئًا ما ممّا لا يزال حيًّا، أو ميتًا حتى، في هذه المدينة.
عندما كانت في السادسة من عمرها، كانت الحرب الأهلية اللبنانية في أوجها. كانت تلجأ إلى اللعب بجهاز راديو ومسجّل أشرطة يستخدمه والداها لمتابعة الأخبار. كانت تستعملهما لتسجيل أغانٍ تحبّها لتتمكّن من الاستماع إليها لاحقًا في أيّ وقت تريد. كان ذلك قبل أن تكتشف أنّ بإمكانها أن تسجّل صوتها هي، وأصوات الناس من حولها، وأصوات المدينة، وأصوات الطلقات النارية! كان هذا واحدًا من تلك الاكتشافات التي لا تعود الحياة بعدها إلى ما كانت عليه قبلها، لأن رنا، منذ ذلك اليوم، صارت تصغي إلى المدينة وتبني أرشيفًا لأصواتها.
لم تتوقّف عن تسجيل أصوات المدينة. في الفترة الأخيرة، صارت تركّز أكثر على "أكوستيك" بيروت، أي على ارتدادات الأصوات وانعكاساتها على جدران المدينة. تتردّد إلى وسط بيروت تقريبًا مرّة كلّ شهر منذ بدء الأزمة سنة 2019. ترصد وتسجّل أصوات المكان. تنتبه أكثر فأكثر إلى أنّ الفراغ في وسط بيروت يتّسع بلا نهاية. وحدها الأصوات من خارج الوسط هي التي تشقّ طريقها إليه: صوت "ززز" تبعثه مصابيح السيارات، أو ألحان بعيدة لموسيقى السهرات الصاخبة في الجميزة ومار مخايل. تكاد تجزم أنّ هذه الأصوات هي أصوات أشباح المدينة، الأموات-الأحياء الذين يطلعون من تحت الأرض، الأموات الذين لم تعرف المدينة كيف تدفنهم بعد.
صوت المكان هو هوية المكان، لكنه ليس واحدًا. يتغيّر صوت بيروت كلّ يوم، لأن المدينة تتشكّل وفقًا لأهواء الناس فيها. مع إغلاق العديد من المقاهي في شارع الحمراء مثلًا، أصبح الرصيف حرًا. تأثّر صوت الشارع بازدياد عدد دعسات الناس على أرصفته. في الفترة التي انقطع فيها المازوت من البلد، وسكت بالتالي هدير المولدات الكهربائية الذي يشكّل نوعًا من خلفية صوتية للمدينة، لاحظت رنا أنّ صوت أذان المغرب الآتي من الضاحية الجنوبية لبيروت يصل على غير عادة إلى بيتها في محيط فرن الشباك.
عام 2002، انتقلت رنا إلى باريس للمشاركة في تدريب في مجال عملها. فور انتهاء التدريب، تلقت عرضًا للعمل والإقامة في فرنسا، مع احتمال الحصول على الجنسية في ما بعد. كان العرض مغريًا لأن الحياة في بلد مستقرّ لم تكن فكرة عاطلة، ثمّ إنها كانت تحلم بالعمل في بلد تكون فيه صناعة السينما مزدهرة، على عكس ما كانت عليه حال السينما في لبنان في تلك الفترة.
كغيرها من اللبنانيين، أرادت أن تهرب أيضًا، لكنها انتبهت إلى أنّ المغتربين لا يهربون من البلد ومشاكله – وهي كثيرة والهروب منها مشروع – بقدر ما يهربون من أمّهاتهم وآبائهم، ومن حبّ سابق يرافقهم، أو من مشاكل مع الجيران ومع الأقرباء والمقرّبين. لم تكن تريد أن تهرب من نفسها. سوف تتصالح مع نفسها وتحلّ مشكلاتها، وسوف تقرّر بعدها أين تريد أن تعيش. عندها فقط لا تكون الهجرة هروبًا.
عندما التحقت بالتدريب، كانت تريد أن تعرف إذا كان حبّها للصوت مجرّد حلم طفولة، لكنّ تلقّيها عرض العمل في باريس جعلها تدرك أنّها، على الأرجح، تجيد ما تقوم به، وإلا لما عرضوا عليها الوظيفة. أرادت أن تبقى في باريس، لكنّها أرادت أيضًا أن تسمع. طرحت على نفسها 3 أسئلة بسيطة:
"شو عبالك تسمعي بباريس؟ ولا شي.
شو عبالك تقولي بباريس؟ ولا شي.
طيب، شو عبالك تعملي؟ عبالي روح عَ بيروت".
حسمت أمرها: سوف تعود إلى بيروت لتكمل ما بدأته عندما كانت تبلغ 6 سنوات فقط.
سألت نفسها مرارًا عما إذا كان قرارها صائبًا. كانت تعرف أنّها، بتركها باريس، تتخلّى عن أحلام كثيرة، لكنها كانت تعرف أيضًا، في مكان ما في أعماقها، أنّها إذا استمعت إلى بيروت فهي تصغي إلى نفسها. في السنوات الماضية، نجحت في العمل على أفلام عالمية، وفي التعاون مع كبار مصمّمي الصوت في العالم من دون مغادرة بيروت، وأصبحت عضوًا في الأوسكار وفي مجموعة "موشن بيكتشيرز – مصمّمي الصوت". قرارها كان صائبًا، لا لأنها نجحت في تحقيق الأحلام التي ظنّت يومًا أنها تركتها وراءها فحسب، بل لأنها اختارت أيضًا القيام بما هو ضروريّ لها، لوجودها: أن تبقى هي في مكانها لئلّا تندثر المدينة. ما النجاح أصلًا؟ النجاح يعني أن يقوم الإنسان بما هو ضروريّ.
تخاف رنا من ألّا يعود هناك شيء اسمه بيروت أو لبنان حتّى. تقلقها قدرة السياسة الصغيرة على محو مدن، على احتلال غيرها، وعلى اللعب بالخرائط. في الأزمات، تصبح الحاجة إلى الأرشفة أكثر إلحاحًا، كمن يُطلب منه إخلاء بيته في غضون دقائق، فيَغرُف منه ما استطاع: ألبوم صور، أغراضًا ثمينة، أمتعة وثيابًا. بهذا الإلحاح، تؤرشف رنا أصوات مدينة بيروت.
للتاريخ، وللناس أيضًا. تبني أرشيفًا لأصوات المدينة، لأن الصورة وحدها غير كافية؛ فالصورة أكثر عرضة للفبركة، أو لأن تكون موضعًا للشكّ في أصليّتها، لكنّ الصوت صوت. هو هُويّة المكان. إذا راح البلد، صوت البلد باقٍ.
تعمل حاليًا على بناء خريطة صوتية للعالم العربي؛ لهذا المحيط الذي يتعذّب كثيرًا. يَجمع مصمّمو الصوت والعاملون في هذا المجال في العالم العربي بعضهم بعضًا لبناء هذه الخريطة التي تسمح للمستخدم بالضغط إلكترونيًا على أي بقعة جغرافيّة لتصدح منها أصوات المدينة والشارع. تضع رنا مشروع بناء الخريطة الصوتية في مواجهة الجيوسياسية. مهما استجدّ في عالم السياسة الصغيرة، ومهما تبدّلت الحدود في الخرائط، تبقى هذه الخريطة غير متغيّرة، لأنها تتشكّل بأصوات أهلها.
بهذا الإلحاح، تؤرشف رنا أصوات مدينة بيروت منذ أن كانت في السادسة من عمرها لئلا تمحو الحرب مدينتها. بعد 40 عامًا، تبقى في مكانها لئلا تندثر المدينة. تضحك: "رح ضلّ هون لحدّ ما يطلبوا منّي بالعربي الفصيح: تفضّلي انقلعي من هون، لأن ما عم تفهمي".

تعرف الآن ما الذي يحثّها أيضًا على البقاء في مكانها، ما الذي يجعل من بيروت بيتًا لها: هي المكان الذي يرقد فيه والدها، والمكان الذي يعيش فيه ابنها. بيروت بيتها، رغم أنّها تسافر كثيرًا بدافع العمل. في الفترة الأخيرة، كانت تتردّد إلى باريس للمشاركة في إقامة فنية، لكنها كانت تعود في كلّ مرّة. أينما رحلت، تعود إلى بيروت كمن يعود إلى بيته كلّ مساء.
ما عدا هذه السفرات، حياتها كلّها تكرار. صحيح أنها تعمل كلّ مرّة على أفلام جديدة ومختلفة، لكنها تأتي إلى المكتب نفسه كل صباح. تشغّل جهاز الكومبيوتر نفسه، تفتح برنامج "برو تولز" الذي أغلقته أمس، وتقوم بعملها مصمّمة صوت للأفلام. تشرب قهوتها وتدخّن سيجارتها على الشرفة نفسها. تحب التكرار، وتحبّ أكثر شعور الألفة في بيروت. يكون قلبها ساخنًا كلّ مرة تكون فيها في بيروت. في بيتها كنبة وطاولة تضع عليها صحن السيجارة ومصباحًا صغيرًا تسند إليه الكتاب الذي تقرأه. التلفزيون أمامها. وإلى جانبها فنجان القهوة في الصباح، وكأس من الكحول في الليل. هذه هي مملكتها. تحور وتدوره وتعود إليها.
لم تعد تذكر آخر مرّة قالت فيها عن أحد أو شيء ما: نيّالو. راضية بما عندها وبما هي عليه، بل إنها سعيدة ومرتاحة. تعمل وتتعلّم أشياء جديدة في الوقت نفسه. لا تزال بيروت تدهشها. المدينة بلا شك كئيبة، توجع القلب، لكنها مُدهشة بقدرتها على قول الأشياء وعلى إنتاج أصوات جديدة. عندما تكون في مزاج سيئ أو في نهاية يوم متعب، تمشي على الكورنيش. تتشاجر مع المدينة. تشعر بأنها تكرهها، لكن عمر الكره أقصر من عمر الحب. بعد 3 ثوانٍ، تسمع فجأة صوت موجة تقترب من الصخر وتنكسر عليه أو تسمع صوتًا جديدًا فتتبعه وتنسى بعد ذلك أنّها كانت تكره بيروت، لتعود وتقع في حبّها من جديد. المدينة كطبيعة الصوت مطّاطية، وبيروت تحديدًا كريمة جدًا بالأصوات.
تخبّئ لها بيروت مفاجآت على الدوام، لكنّ المفاجأة الكبرى جاءت على لسان كريم، ابنها الذي يبلغ 12 عاماً. في إحدى المرّات، قالت رنا لكريم إنهما ربما يضطران يومًا ما إلى ترك بيروت بسبب الأزمة الاقتصادية. قال لها إنه لن يترك بيروت ولن يرحل معها إذا قررت الرحيل. شرحت له أنّها لا ترغب في السفر، لكنها مستعدة للرحيل من أجله لا من أجلها. أجابها: "عنجد ماما؟ نْجينا من الانفجار وهلق بدّك تفلّي؟ عنجد عنجد أوقات بتفاجئيني".
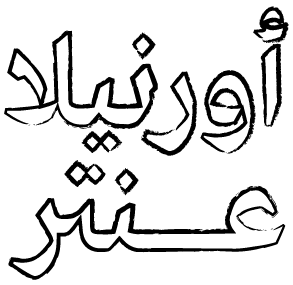
* سُكّان الصور هو عنوان رواية لمحمّد أبي سمرا، صادرة عن دار النهار عام 2003
** اقتباس من كتاب "الأرض وأحلام يقظة الراحة: بحث في صور الحميمية"، لـ غاستون باشلار
*** قول للقديس أوغسطينوس
**** اقتباس من كتاب "عبور الركام" لـ أنطوان الدويهي، 2003