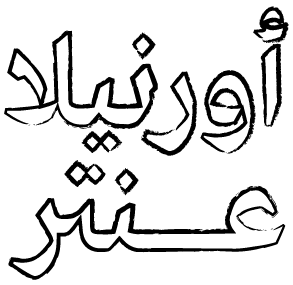في شهري الأخير في مدينة تولوز، وفي فرنسا بشكل عام، صرتُ أفكّر في الأشياء التي جعلت حياتي هنا حياة. في البداية، فكّرت في الصداقات التي بَنَيتُها مع الأصدقاء في هذه المدينة. عدد من هذه الصداقات سيبقى خاصًّا بالمدينة، وعدد أقل سأصحبه معي أينما ذهبت؛ هؤلاء هم الأصدقاء بالمطلق الذين لا تتعلّق صداقتي بهم بالمكان ولا بالجغرافيا.
بعد ذلك، انتبهتُ أن هناك أمراً آخر يجعل الحياة هنا حياة؛ أمراً آخر غير الأصدقاء: الناس الذين ألتقيهم كلّ يوم، والذين لا أعرف أسماءهم ولا يعرفون اسمي بالضرورة، لكنّنا نعرف بعضنا بعضاً. هؤلاء هم ناس الحياة اليومية، يصنعون، مع الأماكن المألوفة، يوميّات الحياة العادية.
في آخر شهر لي في مدينة تولوز، التقطت سلسلة من الصور الفورية لأشخاص وأماكن توثّق حياتي اليومية في تولوز ونشرتها تحت عنوان "يوميات الحياة العادية"، انطلاقًا من اهتمام مجاز بالحياة اليومية والناس العاديّين. (نشرت هذه النصوص تباعًا في حسابَي مجاز في إنستاغرام وفيسبوك، وجمعتها لاحقًا في هذه المدوَّنة).
عدتُ في أحد الأيّام من السوق بعدما مررت بدكّان عمر للخضار والفاكهة. لم أكن أعرف اسمه بعد (سألته عنه البارحة عندما التقطتُ له هذه الصورة). في البيت، قلتُ لزوجي إنّ جارنا "الخُضرجي" سيقفل دكّانه لشهر كامل، لأنه ذاهب إلى الجزائر لقضاء عطلة الصيف، وليرى أمّه ويمضي بعض الوقت معها، لأنّ العائلة أهمّ شيء في الحياة. سألني زوجي عندها: "إنتِ شو عرّفك بكلّ هيدا؟"، فقلتُ له إنّني سألته عن العطلة، وحدّثته فحدّثني، وأخبرني كل هذه الأخبار.
أقرأ أحيانًا جملًا واقتباسات يشاركها البعض في مواقع التواصل الاجتماعي، مفادها أنّ أهمّ المحادثات هي المحادثات العميقة التي تتناول مواضيع الحياة والمستقبل والوجود، والتي تجريها مستلقيًا تحت النجوم أو على شاطئ البحر وما إلى ذلك.

هذه المحادثات مهمّة طبعًا، لكنها لا تلغي أهميّة المحادثات الصغيرة بين الناس عن الطقس والمدينة والعائلة والأولاد والعمل وغلاء الأسعار. على العكس تمامًا. قرأت مرّة مقالًا عن اختفاء المحادثات الصغيرة من عالمنا، لأننا عندما نكون في انتظار رحلة في القطار أو خلال الوقوف في الطابور أمام الفرن أو في قاعة انتظار، يتصفّح كلّ منا هاتفه بدلًا من التحدّث إلى الآخرين.
انتبهتُ عندها أنّني فعلًا أحب المحادثات الصغيرة مع الناس، وأنّني أجد من المستغرب جدًا أن ألتقي عمر كل يوم، وألّا أعرف عنه شيئًا، ولا يعرف أيضًا شيئًا عنّي.
إيفا هي جارتي في البناية القديمة. "جارتي" و"البناية القديمة" كلّها كلمات لم أتخيّل يومًا أن أقولها هنا في فرنسا، وذلك بسبب الأحكام المسبقة التي نكوّنها عن شكل العلاقات في أوروبا. بعض هذه الأحكام صحيح، والجزء الأكبر منها مبالغ فيه جدًا. المهمّ في هذا كلّه أنّني لم أتخيّل أوّلًا أن تكون لي جارة في تولوز، وثانيًا أن أعيش ما يكفي من الوقت في هذه المدينة بشكل يسمح لي أن أحكي عن بيت في البناية القديمة وآخر في البناية الجديدة.
تعرّفت إلى إيفا في ردهة الطابق السابع من البناية. كنتُ أقف مع زوجي، وكانت مع حبيبها، كلٌ أمام باب بيته. قلنا لبعضنا بعضًا: "بونسوار"، ثم أدرنا ظهرنا عائدين إلى شقّتَينا. في اللحظة الأخيرة، قلتُ لنفسي: "بحكي أو ما بحكي؟"، ثم استجمعتُ قواي ودعوتهما لشرب شيء ما عندنا: قهوة أو شاي أو كأس من الكحول. لا فرق.

وافقا، فسرنا معًا نحن الأربعة إلى غرفة الجلوس عندنا وتحدّثنا مطوّلًا. بعدها، قاما بدعوتنا إلى العشاء في شقّتهما، فخبزت "كيكة" وأخذتها معي. أثناء العشاء، عرفتُ أنّ عيد ميلاد إيفا يصادف هذا الأسبوع، فارتجلنا احتفالًا، وأضفنا شمعة إلى قالب الحلوى.
بعد ذلك، دعوناهما إلى بيتنا، وحضّرنا لهما طبقًا لبنانيًا. كانت هذه الدعوات إلى مشاركة الطعام بيننا جميلة جدًا، لكنّ الأجمل منها كان يحدث بين الدعوة والأخرى لا أثناءها: كنّا نتبادل صحون الطعام بيننا بلا مناسبة. إذا حضّر الواحد منّا قالبًا من الحلوى، كان يرسل إلى الآخر حصّة منه. وإذا أرسلت والدة حبيب إيفا حلوى من المغرب، كانا يرسلان إلينا حصّتنا منها. تبادل الصحون هذا بيننا ذكّرني بجدّتي التي كانت ترسل معنا، أختي وأنا، عندما كنا صغيرتَين، صحونًا من الطعام للجيران.
علّمتني الهجرة مرّة ثانية أن الصداقات تُبنى على مهل. في فرنسا، لم يعد بناء الصداقات أمرًا عاديًا لا أنتبه له، بل صرت ألاحظ كيف نعمّر الصداقات كما نعمّر بيتًا. انتبهتُ بوضوح أكبر لذلك عندما قارنت علاقاتي بالناس هنا عند لقائنا في المرة الأولى بعلاقاتي بهم الآن وأنا أودّعهم للمرّة الأخيرة.
بحثتُ عن ليا طويلًا قبل أن أجدها. منذ أن قررتُ أن أترك شعري على سجيّته مجعّدًا ومتطايرًا حول وجهي، انتبهتُ إلى أنّ قصّ الشعر على الناشف أفضل من قصّه وهو مبلّل وأملَس. بهذه الطريقة، أخرج من الصالون وأنا أعرف تمامًا كيف سيبدو شعري كلّ يوم بعد أن أخرج من الحمّام.
وجدتها أثناء بحثي الطويل عن صالون لتصفيف الشعر في مدينة تولوز. كيف أعيش في مدينة وأسمّيها مدينتي من دون أن يكون لي فيها مصفّف(ة) للشعر؟ قصصت شعري قصيرًا للمرّة الأولى في صالون ليا منذ سنتين بالتمام، في أيلول/سبتمبر عام 2021، وصرت أزورها بشكل دوريّ لأنني أقصّ شعري كلّ مرة عندما يكاد يطال كتفَي. هذا كلّه لأقول إنني زرتها كثيرًا، لكنّني لم أجدها فعلًا ودودة إلّا البارحة عندما زرتُها لكي أقصّ شعري مرّة أخيرة قبل مغادرة تولوز ولكي ألتقط لها هذه الصورة..

بدت لي ودودة أكثر من العادة، وراحت تحدّثني وتسألني عن طبيعة عملي وعمل زوجي، وبدت متحمّسة أكثر منّي ومنه لوجهتنا المقبلة.
قبل ذلك، كانت لطيفة بدرجة عاديّة. كنت في الحقيقة حذرة في التعاطي معها، لأنها أوحت لي بأنّ خلقها ضيّق. في إحدى المرّات، كانت تقصّ شعري عندما دخلت شابّة أجنبيّة تتحدّث بفرنسية غير متقنة لتطلب موعدًا منها، فسألَتْها: "شو بدّك تعملي عالمزبوط؟"، فقالت لها الشابة إنّها لا تعرف تمامًا ماذا تريد أن تفعل بشعرها، لكنّها سئمت منه وتحتاج إلى بعض التغيير في مظهرها. أعتقد أنّ الشابة كانت تحتاج إلى أن من يقول لها إن هذا الموديل يليق بوجهها أكثر من غيره أو هذه الصبغة تناسب لون عينيها لا أكثر.
لكنّ ليا أجابتها بشيء من العصبيّة: "لا، أنا هيدا ما عندي منّو، ما فيكي تاخدي موعد ومش عارفة شو بدّك، كيف بدّي أعرف شو أعملّك"، ثم تابعت: "بعدين هيدا راسك مش راسي، إنت اللي آخدتي معك عالبيت مش أنا".
ارتبكت الصبية واستأذنت وخرجت من الصالون. التفتت إليّ ليا وتأفّفت منها. لم أقل لها شيئّا لأنها كانت تحمل مقصًّا فوق رأسي.
ذهبت مرّة إلى صالون آخر في تولوز. لم تكن النتيجة سيئة أبدًا، لكنّني اشتقتُ إلى ليا. أنا وصديقتي سُهى، التي تتردّد أيضًا إلى صالون ليا، نسمّيها "ليّول" أو "الستّ ليّول"، لأنها تفعل وتقول ما تريد ونعود إليها في كلّ الأحوال.
اليوم الرابع من سلسلة "يوميات الحياة العادية" لا يحكي قصّة شخص، بل قصّة مكان: مكتبة "أومبر بلانش" في وسط المدينة؛ أكبر متجر لبيع الكتب في تولوز. شكّلت منذ اليوم الأول لوصولي إلى تولوز جزءًا من حياتي اليومية والعادية في هذه المدينة.
لم أتعرّف إلى الموظّفين فيها، لكنّ وجوه بعضهم أصبحت مألوفة لي. أحدّث أحدهم فقط عندما لا أجد كتابًا في المكان الذي أتوقّع أن أجده فيه. يُجيبني عن سؤالي وينتهي الحديث هنا. أمّا الوقت الباقي، فليس للناس في المكتبة، بل للكتب.
أدخل أحيانًا إلى المكتبة بلا غاية محدّدة، لمجرّد أنّني مررت أمامها كأنني ألقي التحية عليها، أو لأنني لا أعرف أين أذهب ولا وجهة معروفة لديّ. أدخل إليها في الربيع والصيف، وأشرب فنجان قهوة بالحليب في المقهى الصغير في باحتها الخلفية. لون الكراسي مع أشعّة الشمس فيها "يفتح القلب".
في إحدى المرّات، قال لي صاحب مكتبة أخرى: "الكتاب اللي ما بتلاقي بمكتبة "أومبر بلانش"، ما تتعذبي تفتّشي عنّه بباقي مكتبات المدينة."

عندما التقطتُ هذه الصورة الفَوريّة لصاحب المقهى، فكّرتُ بيني وبين نفسي أنّه لا يعرف شيئًا. لا يعرف شيئًا عن العلاقة التي تجمعنا، مجاز وأنا، بمقهاه. لا يعرف أنّ المقهى الذي أسّسه مع والديه في آذار/مارس 2022 شكّل محطّة من محطّات المشروع الذي أسّسته في نهاية العام نفسه. لم أقل له شيئًا، لكنني سألته عن اسمه، فأجابني: كريستوف.
أطلقتُ أوّل عدد من مجاز في هذا المقهى. لم يكن اشتراك الإنترنت قد فُعِّل في بيتنا الجديد. لذلك، كنتُ ألجأ يوميًّا إلى مقهى "كوبي". جلستُ على مقعد أمام طاولة صغيرة عليها اللابتوب وفنجان قهوة بالحليب، وقمتُ بتحميل العدد والفيديو الذي يرافقه. ضغطتُ على زرّ "النشر"، ولم أنجح في تحميلهما. لسبب ما، كان الإنترنت معطّلًا في المقهى. توتّرتُ كثيرًا وبكيتُ لأنّني، في رأسي، كنتُ مقتنعة بأنّ المشروع بأكمله سيفشل إذا تأخرت في إصدار العدد في الوقت الذي حدّدته لنفسي.

تنقّلتُ وحاسوبي وفنجاني ودموعي من مقعد إلى آخر بحثًا عن إرسال أفضل إلى أن تمّت العمليّة بنجاح.
بعدها، أصبح لدينا إنترنت في البيت الجديد، لكنّني واظبتُ على ارتياد "كوبي" للعمل، ربّما لأنني بكيتُ مرّة فيه، وربّما لأنّه قريب جدًّا إلى البيت، وقهوته لذيذة، والكيكات التي يحضّرها تبدو كعناقٍ في فمي، ولأن الموسيقى رائعة، وضوء الشمس على حيطانه الزرقاء تدفئ القلب.
في الفترة الأولى التي تلت افتتاح المطعم، كنّا نقول إنّنا سوف نتغدّى أو نتعشّى في مطعم "شيه تيتا"، وتعريبه الحرفيّ من الفرنسيّة هو: "عند جدّتي". كان هذا في الفترة الأولى. بعد زيارتنا للمطعم في المرة الأولى، ثم الثانية فالثالثة، تغيّر اسمه بالنسبة إلينا. صرنا نقول: "رايحين عند محمّد"، حتّى إنّنا أصبحنا نروح ونجيء عند محمّد -صاحب مطعم "شيه تيتا"- من دون أن نتغدّى أو نتعشى. صرنا نزوره بلا سبب، سوى أنّنا على مقربة من المطعم، أو لأننا ببساطة نودّ أن نسلّم عليه أو أن نشرب القهوة معه، لا عنده.
في المطعم عند محمد، ختمنا بحثنا عن مطعم لبنانيّ حقيقيّ في تولوز: "ورق العنب بزيت" كما تحضّره جدّتي، والطاولات أكثر عرضًا من طاولات المطاعم الفرنسيّة الصغيرة التي لا تناسب شكل السفرة اللبنانية وصحون المازة التي يتشاركها الناس، وصوت فيروز الذي يملأ المكان.

الأهمّ من هذا كلّه أن محمد يستقبلنا بنفسه، أو بالأحرى "يتأهّل" بنا.
في البداية، حدّثته عن مجاز، فتعرّف إلى المشروع، وقرأ قصص العدد صفر عن الاغتراب. بعدها، صرنا نتحدّث عن مجاز بشكل أعمق، ونشرب القهوة معًا لنتبادل الأفكار بشأن تطوير المشروع، ولا سيما صناعة الفيديو؛ مهنة محمّد الأولى.
في المرّة الأخيرة التي تناولنا فيها طعام العشاء عند محمّد قبل رحيلنا من تولوز، كان صوت فيروز يملأ المكان كالعادة. كنت أعتقد في السابق أنّ المغتربين يبالغون، لكنها حقيقة: لا أستطيع الاستماع إلى كل أغانيها في الغربة لأنها تحزنني.
تحزنني جملة: "سنرجع يومًا إلى حيّنا"، رغم أنّني لم أكن أنتبه لها عندما كنت أسمعها في لبنان. سمعتها في تلك الليلة في المطعم عند محمّد، وشعرت بأنّ الهجرة من تولوز، ومن مطعم "شيه تيتا" اللبناني في تولوز تحديدًا، ستكون هجرتي الثانية من لبنان.
للوهلة الأولى، كدت أكتب عنوان اليوم السابع "البيت القديم" بدلًا من "البيت"، لكنّني انتبهت بسرعة أنّ بيتنا في حيّ "المينيم" في تولوز ليس بيتنا القديم، بل بيتنا الوحيد في هذه المدينة. البيت الجديد الذي انتقلنا إليه في أواخر عام 2022 ليس بيتًا، لأنني لم أحبه، ولم أشعر يومًا فيه بأنّني في بيتي. سأفعل كما يفعل الفرنسيون، أي أنّني سأسمّيه شقّتنا بدلًا من بيتنا.
في فرنسا، ليس كل منزل بيتًا. إذا كان الواحد منّا يسكن في استوديو، فسيقول إنّه يعيش في استوديو، وإذا كان يسكن في شقّة، فسيقول إنّه يسكن في شقّة. أمّا البيت، فهو البيت المنفرد الذي كنّا نرسمه على ورقة بيضاء عندما كنّا صغارًا: مكعّب يعلوه مثلّث، له شبّاكان كعينَين وباب واحد كفَمٍ.

في حيّ المينيم، كنّا نسكن في شقّة، لكنّني كنت -ولا أزال- أسمّيها بيتنا. لا بدّ من أنّ الفرنسيين الذين قابلتهم وقلت لهم إنّنا نعيش في بيت في "المينيم" ظنّوا أنّنا فاحشو الثراء. "معليش".
لم أعتقد يومًا أنّني سأحبّ الحيّ إلى هذه الدرجة، حتى إنّني كنت أشعر بأن قلبي يفتحُ عندما نعود من سفر ما ونصل أخيرًا إليه. كانت أمّي تقول إنّ قلبها يفتح عندما تعود من بيروت إلى زغرتا، كأنه يكون مغلقًا عندما تخرج من بلدتها.
كنت أحبّ العودة إلى "المينيم"، وأحبّ الساحة الواقعة في قلب الحيّ التي يتجمّع فيها الأشخاص نفسهم كلّ مساء. اعتدتُ وجود عازف يلعب الموسيقى كلّ يوم أمام الجمهور نفسه المؤلّف من ثلاثة أو أربعة أشخاص. هم أيضًا نفسهم، يجلسون على مقعد مثبّت بالأرض. ربّما لا يتغيّرون من يوم إلى آخر لأنهم كالمقعد؛ ثابتون مكانهم.
في الساحة نفسها، كنت أطلب بيتزا من "الفان" الذي يُركن كلّ يوم في الحيّ نفسه، كأنّه هو أيضًا ثابت في الأرض بلا دواليب تنقله من مكان إلى آخر. كان بإمكاننا أن نحصل على بيتزا مجّانًا بعدما نكون قد اشترينا 10 علب من البيتزا، واحتفظنا بقصاصة ورق صغيرة من كل علبة، لكنّنا -للأمانة- لم نأكل الكثير من البيتزا. لم نكن نحتفظ بالقصاصات أصلًا، ربما لأننا لم نكن نريد أن نعدّ البيتزا على أصابعنا.
كنتُ أريد أن تكون لي صديقة في تولوز؛ صديقة أكتب لها رسالة نصيّة قصيرة من كلمتين: "أينَ أنتِ؟"، فتجيبني: "بالبيت، تعي"، فنلتقي بهذه البساطة. أطرق باب بيتها بلا أن أكتب لها حتى: "أوكي، جايي". أتمدّد على سريرها أمام الشباك، وتجلس على الكرسي قبالتي. أفتح علب الشوكولا وآكل ما أريد منها، حتى إنّني أضيّفها من العلبة كأنّها هي ضيفتي.
في بلاد المهجر، تُبنى علاقات الناس برعاية "غوغل كالِندر": ترسل رسالة إلى صديق في شهر تمّوز/يوليو. تطمئن إلى حاله، وتسأل عن أخباره، ثم تتفق معه على اللقاء يوم السبت في الثاني من شهر أيلول/سبتمبر في تمام السادسة مساءً. لا أبالغ، فالكلّ مشغول، والكلّ يسافر كثيرًا، ويتنقّل كثيرًا، ويعمل كثيرًا، والمسافات بعيدة. عندها، تُضطر إلى ترك ملاحظة على روزنامة هاتفك ليذكّرك بالموعد الذي ضربته مع صديقك بعد شهر وأسبوع، لكنّني وجدتُ سُهى.

وجدتها على "إنستغرام"، ثم تواعدنا للمرّة الأولى على "سْطَيحة" في الطابق الرابع من متجر كبير وسط المدينة يبيع كلّ شيء.
كان اللقاء بيننا خجولًا. كنّا في بداية هجرتنا إلى فرنسا، وفي بداية خروجنا من الحجر الصحي بعد جائحة كوفيد 19. صرنا نلتقي بعدها بوتيرة متباعدة، إلى أن أصبحنا نتحدّث كل يوم ونلتقي تقريبًا كل يوم. نلتقي نحن الثلاثة -الياس زوجي وسُهى وأنا- يوم الأحد في بيتنا. نطبخ معًا، ونأكل معًا، ونتحدّث كثيرًا، ونضحك أكثر، ونسخر من بعضنا بعضًا بلا نقطة خجل. أرافقها إلى مواعيد الطبيب، ونتشارك صالونًا واحدًا لتصفيف الشعر –صالون الست ليّول– ونطبخ لها طبخات تحبّها، فيما تحضّر لنا حلويات بيروتية لم نسمع باسمها من قبل. نهوّن على بعضنا بعضًا الطريق.
كنتُ أريد أن تكون لي صديقة في تولوز، لكنني كنت قد نسيت كيف تُبنى الصداقات، وكيف تأخذ وقتها ككلّ العلاقات الأخرى، وككلّ شيء في هذه الحياة. في إحدى المرّات، كان بيتنا الصغير يعجّ بالناس بشكل عفويّ: الياس وصديقنا الحوراني يحضّران لنشاط على طاولة المطبخ، وسُهى وأنا على الكنبة في غرفة الجلوس نبحث في شياكة الفرنسيات وذوقهنّ الرفيع في اللباس، ثم أتى صديقنا عثمان لزيارتنا على غفلة وبيده علبة ماكارون (حلويات فرنسية).
في ذلك اليوم، قالت لي سُهى شيئًا لا أذكره، وأنهت جملتها بـسؤال: "ما هيك يا أورنيليتا؟"، فأجبتها: "مبلى هيك يا توتي"، ثم نظرنا إلى بعضنا بعضًا، و"غشينا" من الضحك في اللحظة نفسها. يومها، عرفتُ أننا سنبقى صديقتين إلى الأبد.
بعضٌ من يوميات حياتي العادية في تولوز، وفي أي مكان بعيد من لبنان، يحدث على شاشة التلفون. أتصل بأختي التي تعيش مع زوجها وولدَيها (صبي عمره 6 سنوات، وطفلة عمرها سنة ونصف سنة) في لبنان عبر فيديو واتسآب، وأسألها فورًا: "وين ولادي؟". تقول لي إنهما في المدرسة أو مع والدهما أو نائمان.
تسألني: "هل تريدين التحدّث إليَّ أنا مثلًا بدلًا منهما أو نقفل الخطّ؟". أقول لها ممازحة إنّني سأتحدّث إليها، إنما على مضض.
يركض ابنها عندما يسمع صوتي يصدح من الهاتف، وأنا، عندما أرى وجهه، أصرخ له: "ماما، ماما" تحبُّبًا، لأنني أحسبه ابني أنا أيضًا، وامتدادًا لعائلتنا الصغيرة المكوّنة من أم وأب وطفلتَين، أختي وأنا. تسمعني فرنسا كلها عندما أعدّد له أسباب حبّي له ولوجهه الجميل وللشامة التي تعلو جبينه.

إذا كنتُ في الطريق، يرمقني الفرنسيون بنظرة غريبة؛ ففرنسا بلد ساكتٌ، أيّ أن أصوات الناس فيها خافتة. أحسب فرنسا مكتبة كبيرة للدراسة ممنوع فيها التحدّث إطلاقًا، لا بصوت مرتفع، ولا حتى بالهمس، لكنّني أحب ابن أختي وابنتها حبًا صاخبًا كحبّ جدّتي لنا عندما كنّا صغيرتين. كانت تدلّلنا بصوت عالٍ جدًا، إلى درجة أنّها، في إحدى المرّات، أقلقت جارتها التي جاءت إلينا مسرعةً لاعتقادها أنّ شيئًا ما أصابنا.
أطمئنّ لكون ابن أختي يعرفني جيدًا ويحبّني. أمّا أخته، فولدت عندما كنت قد هجرتُ لبنان منذ أكثر من سنة. لم أر وجهها في يومها الأوّل على وجه هذه الأرض. رأيتُ صورًا لها على شاشة تلفوني. عندما أرى وجهها على الشاشة، أصرخ لها: "ماما".
منذ بضعة أيّام فقط، أجابتني للمرّة الأولى بـ"ماما". قالت لي أختي إنها لا تقول "ماما" لأحد، حتى لها هي؛ أمّها التي أنجبتها. طلبتُ من أختي أن تهمس لها كل ليلة قبل أن تنام أنّ خالتها تحبّها كثيرًا، لكنّ أختي طمأنتني قائلة: "لا تقلقي، الأطفال يعرفون من يحبّهم حقًا"، ثم أضافت: "الأطفال يعرفون أيضًا من تحبّ أمهم، ويحبّونه بدورهم بشكل طبيعي".
كنت أُسألُ كثيرًا عمّا جاء بي إلى تولوز: الدراسة أو العمل أو الهجرة؟ فأجيبُ أنّني جئت إلى تولوز بدافع الحبّ. إجابتي هذه كان يليها سكوت أو ضحكة. الحبّ وحده لا يبدو دافعًا كافيًا، فأستفيض في التحدث عن عمل زوجي وعن قرار الارتباط به رغم أنّنا لم نكن نعيش في البلد نفسه.
لو قلتُ إنّني هاجرتُ لمتابعة الدراسة أو لقبول عرض وظيفيّ براتب أعلى أو للبحث عن أفق جديد، لما اضطررتُ إلى الشرح. أذكُر اليوم الذي خطرت لي هذه الفكرة البسيطة: متى أصبح الترحال لدوافع اقتصادية أعلى شأنًا من الحبّ؟
في الأشهر الأولى في فرنسا، لم أكن قد أسّستُ مجاز، ولم أكن أعمل في الترجمة والكتابة بعد. كنتُ أقرأ روايات، وأمشي في المدينة، وأتمدّد على العشب في الشمس، وأخبز كيكة مرّة في الأسبوع.
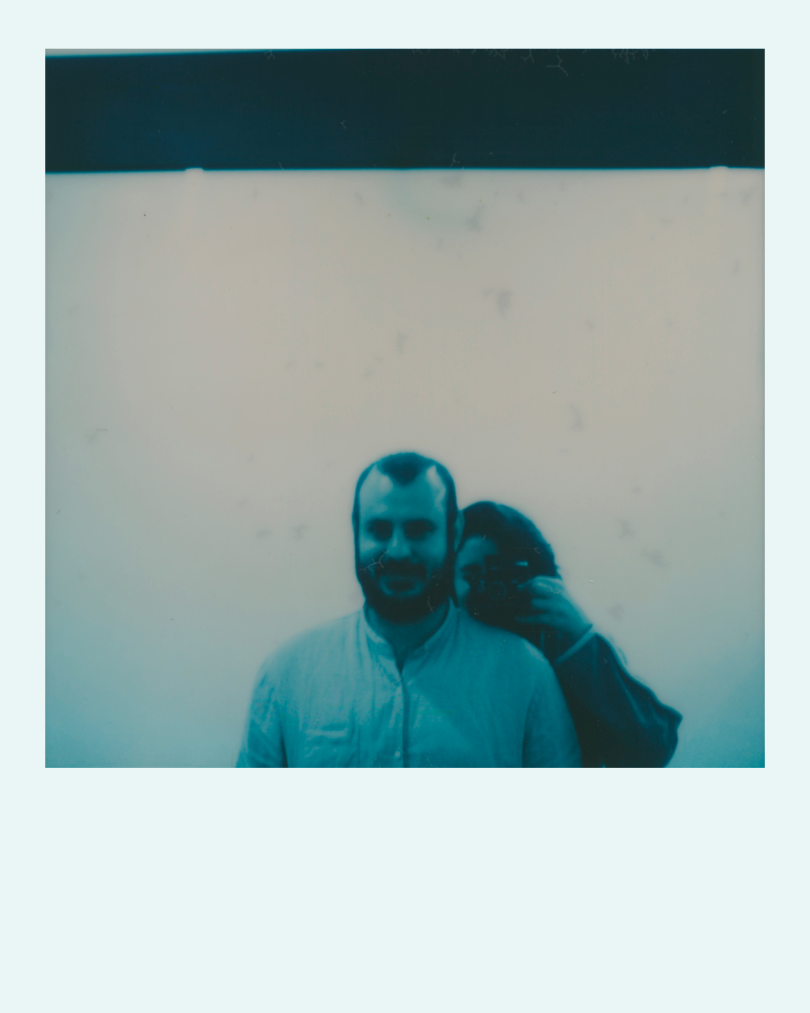
كنتُ أمضي وقتًا طويلًا في المطبخ مع زوجي: نشرب النبيذ بينما يطبخ. يحملني فأجلس بجانبه على المنضدة لنتحدّث ولأقرأ له تعليمات الوصفة من كتاب "مذكّرات مطبخ تولوز-لوتراك" الذي أهدتنا إيّاه صديقة لمناسبة زواجنا.
كانت هذه المرحلة من أجمل مراحل حياتي، لكنّني لم أستمتع بها بالكامل إلا عندما انتبهت أنّه يحقّ لي ألّا أكون منتجة، وأن أتخذ خيارات كبيرة بدافع الحبّ فقط. بعد مرور سنتين، قرأتُ كتابًا عن الحبّ للكاتبة النسوية الأميركية بيل هوكس. تقول في مقدّمته إنّ الحبّ لم يعد ذريعة قويّة، ولا يجرؤ أحد على البوح بحاجته إلى الحب، وأنّها حين تبوح بذلك للمقرّبين إليها، يسارعون في الرد عليها بخطاب عن أهميّة الاكتفاء بالذات وحبّ الذات وتطوير الذات. كلّ مرّة عندما تتحدّث عن الحبّ، يضحك الآخرون عليها. الحبّ ساذج وسخيف.
لكنّني انتبهتُ إلى أنّ الحبّ مهمّ، وانتقلتُ إلى تولوز، وبعدها إلى روما، بدافع الحب. أحبّ أن أنام بجانبه، وأن أستيقظ بجانبه، وأن أقنعه في الصباح بألّا يذهب إلى المكتب لكي نشرب القهوة معًا "على البلكون عَ رواق". أجمل ما في الأمر أنه يقتنع ويبقى، فنشرب القهوة معًا، ونتحدّث كأنّنا لم نرَ بعضنا بعضًا منذ 70 يومًا، ثم نمضي للعمل على طاولة السفرة.
حياتنا عاديّة. نمضيها في العمل والطبخ معًا واكتشاف أنفسنا مع بعضنا بعضًا وعلى حدة. نمضيها في التحدّث كثيرًا ومطوّلًا عن الحبّ والحياة، وعن أشغالنا، وعن مجاز والثقوب السوداء وأحلام الطفولة وأوجاعها ومستقبلنا معًا.
نمضيها في المرح والتسلية والضحك، وفي الشوارع والمطبخ، وعلى الشرفة، وفي غرفة النوم، وفي مطاعم نحبّها ومقاهٍ نألفها. حياتنا عاديّة جدًا. نمضيها في البحث عن سبل لجعل علاقة الحبّ هذه أكثر عدالة. كلّ شيء في حياتنا عاديّ جدًا، ما عدا الحبّ الذي يجمعنا.